الملف كامل:
ثالوث الشؤم
إيلي حنا
هي المفاهيم المغلوطة التي لا تخضع لأي نقد فتطفو على السطح وتتحكم في المقاربات كلها. من قال إن المجتمع السعودي، برمته، وهابيّ النزعة؟ ومن قال إنّه حاضنة تنظيم «داعش» الذي فرد أجنحته في سوريا والعراق، وها هو يتهدد السعودية؟ مقاربات لأسئلة كهذه، ولو أتت من منظرين عرب ومسلمين، يغلب عيها الطابع الاستشراقي.
صحيح أن علاقة الأمير/ الشيخ طبعت التاريخ السعودي منذ قيام المملكة. وصحيح أيضاً أن الوهابية حالة تكفيرية مقيتة هيمنت على الفضاء السعودي إلى حد تحولت فيه إلى شتيمة تضاف إلى النعوت السلبية للمملكة السعودية. لكن العلاقة بين المؤسسة الدينية والعائلة المالكة والمجتمع في هذه المملكة أكثر تعقيداً مما قد يعتقد البعض.
حتى «داعش» التي لا شك ظهرت من رحم تلك الوهابية التكفيرية التي أمنت لها حاضنة ثقافية، فيما وفرت لها المؤسسة الدينية وكثير من المتمولين حواضن مالية ولوجستية، تعتبر عنصراً إشكالياً في هذه العلاقة المعقدة. هي في صدام مع كثير من المدارس الفقهية كالفكر السروري والجامي والسلفي (بتفرعاته) التي تنتشر في السعودية، في الوقت الذي تنهل فيه، على سبيل المثال لا الحصر، من الكثير من مرجعيات الإخوان المسلمين.
من هنا، يؤكد البعض أنّ التعاطف مع التنظيمات «القاعدية» ليس ابن بيئة الجزيرة العربية فقط، رغم ما تحمله من رواسب وتراكمات توّجت في مرحلة «الأفغان العرب» خلال احتلال السوفيات لأفغانستان. يحاججون أن في سوريا والعراق والمغرب العربي ما يدفع إلى البحث الجدي عن ظواهر الارتماء في أحضان أحفاد ابن لادن. يحسم هؤلاء بأن فهم بنية الدولة السعودية يجتنبه قصور كبير. لكن آل سعود لا يتركون مجالاً للوضوح. يكرهون الأسئلة والصور. لا نقاش مفتوحاً وجدّياً حول المجتمع بقبائله ومدارسه وعلاقاته. «المحرّم» طبع «وطن العائلة» بكلمة، ثمّ ترادف الاثنان مع «داعش».
حين ظهرت في الفترة السابقة أقلام في صحف محسوبة على الرياض تنتقد الوهابية، اعتقد البعض أنّ «حدثاً جللاً» يحصل في المملكة. يؤكد هؤلاء أن انتقاد الفكر الوهابي ليس بجديد، وقابله مد وجزر في طبيعة العلاقة بين الدولة والمؤسسة الدينية. آل سعود يريدون احتواء «المشايخ» وتشذيب عقيدتهم بما يناسب إحكام سيطرتهم على المجتمع وصورتهم أمام من «اختيرَ» لهم من أصدقاء في الغرب. شراكة بين «الشيخ» و«الأمير» هي مفتاح الفهم. الأول عدّة الثاني للحكم. كان ولا يزال كذلك. تنقص «العدّة» أداة أو تزيد بحسب الظروف الداخلية والدولية. هنا يبدأ التهذيب والتكييف حسب الحاجة.
«الأخبار» حاولت سبر أغوار تلك العلاقة المركبة في مقالات أربعة لكتاب سعوديين نستعرضها في ما يأتي:
الوهابية في قلب الجدل
حنان الهاشمي
في ظل الهامش الضيق لحرية التعبير في الصحافة السعودية، والذي تختلف أبعاده، وقد يتلاشى كلياً، تبعاً للظروف السياسية الداخلية أو الخارجية؛ يُضطر الكُتّاب عادة إلى تكييف أقلامهم مع المناخ العام عند اختيار المواضيع التي يتناولونها بالنقد أو التحليل؛ وذلك لتجنب المضايقات، أو تجنب قرار بالإيقاف والمنع عن الكتابة.
ويمكن أن نأخذ طريقة التفاعل مع «الوهابية» مثالاً على ذلك، فبعدما كان نقدها في وسائل الإعلام إشكالياً، وواحداً من الخطوط الحمراء التي يُعرّض تجاوزها، الأفراد والمؤسسات، للمساءلة أو الإيقاف؛ كما حدث مع كل من الكاتب والأكاديمي خالد الدخيل، والإعلامي عبد الرحمن الراشد؛ حين مُنع الأول من الكتابة في صحيفتي «الاتحاد» الإماراتية، و«الحياة» السعودية، على أثر سلسلة مقالات تناول فيها الوهابية، وتعرض الثاني للفصل من قناة «العربية»، لمدة يومين، بعدما بثت القناة وثائقياً حولها، أو كما حدث مع رئيس تحرير صحيفة «الوطن» السعودية الأسبق جمال خاشقجي، حيث أُقيل من منصبه لسماحه بنشرمقالٍ ينتقد الوهابية.
في الآونة الأخيرة، يشهد الإعلام المرئي والصحف موجة من النقد والتشريح، العلني، للوهابية، ما يدفعنا إلى التساؤل عمّا قد يعنيه هذا التوجه حالياً، وخاصة أنه يأتي بالتزامن مع مشاركة السعودية في التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية «داعش».
تنوّعت أساليب الكُتّاب في تعاطيهم مع الوهابية، فهناك من حرص على وضع الحركات الجهادية السلفية في سياقها التاريخي والسياسي، وعدم الاكتفاء بالمراجعات الدينية، كما فعل الكاتب خالد الدخيل في سلسلة مقالات، منها مقاله (مراجعات «الوهابية» تأخرت كثيراً)، ويرى فيها أنّ أهم ما تمخض عنه ظهور «داعش» هو ما يبدو أنه مراجعة فكرية لأدبيات الحركة الوهابية، وأن هذه المراجعات يجب أن تستمر وتتعمق، مع توجيهه النقد لما اتّسمت به أغلب المراجعات من طغيان النَفََس الديني عليها، وتجاهل الإطار التاريخي والمعطيات الاجتماعية والسياسية.
من ناحية أخرى، اتجهت بعض الأقلام إلى محاولة خلق تمايز بين أيديولوجيا السعودية، وأيديولوجيا تنظيم الدولة الإسلامية، أو نفي وجود علاقة بين الوهابية والتنظيم. كما فعل كل من سعود السرحان ونواف عبيد في مقالهما المعنون (السعوديون قادرون على سحق «داعش»)، حيث حاولا التأكيد على أن السعودية ليست المنبع لظهور «داعش»، بل اعتبراها الهدف الرئيس للتنظيم؛ لأن طريقه نحو الخلافة يمرّ عبرها، فهي أرض الحرمين، المكي والنبوي. كما حرصا على نفي اتباع منهج السلف أو «الوهابية» عند «داعش»، معتبرين أنّها تتبع «مذهب الخوارج»، المناقض تماماً للسلفية.
وفي السياق ذاته، كتب عبد الله بن بجاد العتيبي مقالاً بعنوان («داعش» بين الوهابية و«الإخوان المسلمين»)، هدف من خلاله الى تثبيت أن تنظيم الدولة الإسلامية لا ينتمي إلى الوهابية بل إلى جماعة «الإخوان المسلمين»، ويمكن أن نصنف هذا المقال، والمقالات المشابهة له، باعتبارها تمثل امتداداً للحملة الإعلامية ضد جماعة «الإخوان المسلمين»، التي أعلنتها السعودية جماعة إرهابية، مطلع هذا العام.
ويرى البعض أنّ الوهابية باتت تشكل عبئاً على الدولة السعودية، وطالب بالانفصال عنها، مثل الكاتب حمزة السالم، الذي وصف الوهابية في مقاله (السلفية على فراش الموت)، بالمتخلفة «تخلفاً شديداً عن جميع مظاهر التطور الإنساني»، في الوقت نفسه الذي وصف فيه الدولة السعودية بـ«المواكبة للحضارة الحديثة»، معتبراً أنّ التناقض بين جسد الدولة وروحها هو سبب بقائها وعدم انتهائها مثل طالبان، مطالباً بالتخلي عن روح الدولة – الوهابية – لأنها تسبب مشكلة في تركيبة المجتمع السعودي، ما يجعلها تمثل عبئاً على الدولة، بعدما كانت مصدر عزتها وقوتها، ووافقه في ما ذهب إليه كتّاب آخرون، مثل عبد السلام الوايل في مقاله (نحن والوهابية بين الامتنان والنقد).
أما الشيخ حاتم العوني، الأكاديمي في جامعة أم القرى، وعضو مجلس الشورى (سابقاً)، فقد تحدث في برنامج (لقاء الجمعة) على قناة «روتانا» عمّا وصفه بـ»الغلو في التكفير عند الوهابية». وربط بين استباحة «داعش» للدماء، وبين كتاب «الدرر السَنِيَّة». وقال: «إن أكبر تهديد اليوم يأتينا من الجماعات التي فهمت منهج السلف فهماً خاطئاً».
إنّ نقد الوهابية ومراجعتها ليس بالأمر الجديد، فقد تعرّضت الحركة للكثير من النقد الداخلي والخارجي. لكن الجديد الآن هو أن هذا الانفتاح على نقد الوهابية لا يناقش غلوّها وتشددها، كما جرت العادة، وإنما يمسّ في جوانب كثيرة منه ارتباطها بالدولة، ويأتي صريحاً بعدما كان يُمرّر تحت غطاء «نقد الصحوة»، والأهم من كل ذلك أنه يأتي في ظل تغيرات إقليمية ودولية هامة. مرّ الفكر السلفي بمراحل عديدة، وطرأ عليه العديد من التغيرات، ويخطئ من يتعامل مع الوهابية باعتبارها تياراً واحداً متجانساً، أو أن لها أيديولوجيا متماسكة متعلقة بنظرتها للدولة وشكل نظام الحكم، فالاتجاهات والأفكار متنوعة داخل ورثة الوهابية، وخاصة مع دخول الأفكار «الإخوانية» على الخط، واختلاطها بالنهج السلفي، وإنتاجها لتيارات مثل «السرورية» و«التيار الإخواني السعودي». ويمكن القول إن سماح السعودية بالوجود الأميركي على أرضها، فترة حرب الخليج، كان له إسهام كبير وجوهري في إبراز هذه التباينات والاختلافات داخل الحالة الإسلامية، ففي حين ركز التيار الجامي (نسبة إلى الشيخ محمد أمان الجامي) على طاعة ولي الأمر طاعة مطلقة، والتحذير من معارضته لما قد تؤدي إليه من «فتن» وإخلال بالأمن؛ تبنّى تيار الصحوة، الذي يشكل مزيجاً من الوهابية والإخوانية، خطاب معارضة سياسية للدولة. فعلى سبيل المثال، عمد عدد من رموز التيار الى إصدار «مذكرة النصيحة»، ومن أبرز مطالبها إعادة الاعتبار للعلماء ودورهم في الحياة العامة باعتبارهم أهل العقد والحل، ومكافحة الفساد، وتوزيع موارد البلاد على المواطنين بالتساوي. كما أعلن عدد من مثقفي الصحوة تأسيس «لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية» للدفاع عن «حقوق الإنسان» التي تقرّها الشريعة؛ الأمر الذي وضعهم في مواجهة مع السلطة ومؤسساتها الدينية ذات التوجه السلفي التقليدي، التي ترى أن مهمتها تتركز على الإصلاح الديني، تاركة أمور الحكم للساسة أو ولاة الأمر، مع تبني نهج «النصيحة السرية للحاكم» من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. في المقابل، تتبنّى جماعات السلفية الجهادية فكرة حمل السلاح والجهاد كوسيلة للتغيير، وترى أنها تحيي نهج السلف الصحيح (أو بالأحرى نهج الوهابية الأصلية) عن طريق إحياء شعيرة الجهاد في سبيل الله، ومن أهم خصائص هذا التيار أنه يرفض كلّ أشكال النظم الحاكمة القائمة، حيث تجاهد أنظمة الحكم في الدول الإسلامية، (لكفرها) أو عدم شرعيتها، إلى جانب جهاد الكفار أو المحتلين، مع رفض البنية الثقافية للمجتمع ووصفه بالجاهلية. هذا الفكر الراديكالي، الذي يرى حمل السلاح طريقاً وحيداً للتغيير، هو أهم ما يميز السلفية الجهادية عن غيرها من السلفيات.
تُشكِّل الوهابية بالنسبة إلى السعودية مصدراً هاماً للشرعية، لهذا السبب، ولأنها موّلت، وببذخ، نشر الوهابية في أنحاء العالم، عن طريق بناء المدارس والمراكز والمساجد السلفية، فضلاًً عن تمويلها برنامجاً واسع النطاق لمساعدة «المجاهدين» الأفغان أثناء الحرب مع السوفيات، وذلك بالتنسيق مع الوكالة الباكستانية للمخابرات، ووكالة الاستخبارات المركزية الأميركية «CIA»؛ بات يُنظر للسعودية – وخاصة من قبل الولايات المتحدة والدول الغربية – باعتبارها حاضنة لما يُسمى «الإرهاب» متمثلاً بالوهابية، ومركزاً مالياً وأيديولوجياً داعماً له. لذا، فإنه في كل مرة تتمّ فيها مناقشة ظاهرة الجماعات الجهادية السلفية كـ«القاعدة» و«داعش»، يُشار بأصابع الاتهام إلى السعودية بتمويل «الإرهاب»، لتجد نفسها مضطرة إلى تفنيد هذه الاتهامات والرد عليها. هذه النظرة التي ترى الوهابية مرادفاً «للإرهاب» حديثة، أي أنها لاحقة لأحداث الحادي عشر من أيلول. أما قبلها، فكانت معظم مراكز الأبحاث الغربية تُقدم الوهابية على أنها حركة موحدة إحيائية ذات طابع طهوري، مع الاعتراف بتشدّدها، دون أن يروا في ذلك أي تهديد لهم ولمصالحهم. وقد يكون سبب ذلك، هو الثقة التي كانت لدى الغرب بقدرة حلفائهم، حكام السعودية، على إحكام السيطرة على الحركة، ومنع أتباعها من التعدّي على مصالحهم.
بعد أحداث الحادي عشر من أيلول؛ تحولت الحركة الوهابية في نظر الساسة والكتاب الغربيين، من حركة توحيدية طهورية، إلى حركة إرهابية مروجة لخطاب الكراهية. فتوالت الدعوات والضغوط على السعودية، لتقوم بإصلاح مؤسساتها ومناهجها التعليمية. تعاملت السعودية مع هذه الضغوط والاتهامات بطرق عدة: فعمدت الى اعتقال أعدادٍ كبيرة من معتنقي الفكر الجهادي، وخاصة بعد تفجيرات الرياض عام 2003، كما أطلقت برنامجاً إصلاحياً للمناهج الدراسية (وخاصة مواد التربية الإسلامية)، بالإضافة إلى إصدار بعض القرارات المتعلقة بالمرأة، مثل منحها بطاقة هوية، وتعيينها في مناصب عليا في الدولة، ودخولها مجلس الشورى، فضلاً عن السماح لها بممارسة مهنة المحاماة. كل ذلك إضافة إلى افتتاح جامعة الملك عبد الله «كاوست» المختلطة، يحمل دلالات كثيرة؛ أهمها تقليص سلطة المؤسسة الدينية وكبح جماحها. ويمكن اعتبار القرار الذي أصدره الملك عبد الله القاضي بإقالة عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ سعد بن ناصر الشثري، بعدما طالب في أحد البرامج التلفزيونية بمنع الاختلاط بين الجنسين في جامعة كاوست، دليلاً على ذلك.
هذا على الصعيد الداخلي. أما خارجياً فتحاول السعودية الإظهار بأنّ طلاقاً تمّ بين السلطة والوهابية، وتقدم نفسها للخارج في نموذج الدولة الليبرالية، التي ترعى حوار الأديان. حتى إن الملك عبد الله صار يُلقَّب بـ«ملك الإنسانية»، إلى جانب لقب «خادم الحرمين الشريفين». ومع ذلك، فإنّ التوقف عن تمويل الجماعات الجهادية (علناً)، يتناقض مع ما قدمته الدولة من دعم لبعض الجماعات الجهادية، في سوريا مثلاً، كما أن الحديث عن طلاق بين السلطة السياسية والوهابية في مجال السياسة الخارجية للدولة؛ قد لا يتسق مع ما يتم تداوله عن دعم تقدمه للأحزاب السياسية السلفية في بعض الأقطار العربية. والأهم من كل ذلك، هو أن جزءاً رئيساً من التحالف ضد «داعش» يقوم على استخدام ما وصفته الناطقة الرسمية باسم الخارجية الأميركية، ماري هارف، «بالأصوات الإسلامية المعتدلة»، متمثلاً بالأزهر والمؤسسة الدينية السعودية، لنزع الشرعية الأيديولوجية عن تنظيم الدولة الإسلامية، وهنا يأتي استخدام المؤسسة الدينية التقليدية في مواجهة خطر «داعش»، مع الأخذ بعين الاعتبار أنّ الاهتمام بنشر الوهابية حول العالم لم يتوقف. أمّا على الصعيد الفكري، فقد قامت المؤسسة الرسمية بدعم باحثين غربيين، لإجراء أبحاث ودراسات، تحاول تقديم صورة مخالفة عمّا يروّج عن الوهابية لدى الغرب، وتبرئتها من تهمة الإرهاب.
يبقى السؤال، هل يمكن أن يتمّ الانفصال بين المؤسستين السياسية والدينية على المستوى الداخلي للملكة؟ وللإجابة عنه، نحن بحاجة إلى فهم طبيعة العلاقة بين المؤسستين، وما الذي تعنيه الوهابية بالنسبة إلى الدولة. تتمثل الوهابية في الدولة على شكل مؤسسات قائمة مثل: القضاء، وزارة الشؤون الإسلامية، هيئة الإفتاء وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بالإضافة إلى الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وجامعة الإمام محمد بن سعود، وغيرها، هذه المؤسسات تتسم بالمرونة بحيث تعيد إنتاج نفسها بشكل دائم ومستمر. وإذا أرادت الدولة التخلي عنها، فإنها ستكون بحاجة إلى تغييرها بالكامل مع ما تحتويه من جيش بيروقراطي مكوّن من مئات الآلاف. وليس صحيحاً أن الوهابية بمؤسساتها تشكل عبئاً على الدولة، بل على العكس، فهي تمثل مصدر شرعية مهم لها، فضلاً عن لجوء الدولة إليها كلما شعرت بضرورة ذلك. حدث هذا بعد اندلاع «الربيع العربي» في عدة أقطار عربية، حين لجأت السلطة إلى فتاوى هيئة كبار العلماء، المحرمة للتظاهرات والمحذرة من خطر الخروج على «ولي الأمر»، مع صدور أمر ملكي يحظر المساس بالمفتي وهيئة كبار العلماء. والنقطة الأهم هي استخدام هذه المؤسسات لقمع حركات المعارضة والقضاء عليها، إذ تخضع كل معارضة سياسية للمحاكمة وفقاً لقيم المؤسسة الوهابية، القائمة على طاعة «ولي الأمر». وبالتالي، فإن تخلي الدولة عن هذه المؤسسات يعني تخليها عن أسلحة هامة تستخدمها كمصدر للشرعية، ولإخضاع المعارضين.
إذا كانت الوهابية مهمة للدولة، فلماذا يُسمح بنقدها بهذا الشكل؟ الجواب يكمن في تحدي «داعش»، الذي يستلزم المزيد من تفريغ الوهابية من مضامينها الأصلية؛ والتي قد تشكل خطورة على الدولة أو تضر بصورتها، وفي الوقت ذاته تستخدمها الدولة الإسلامية اليوم لتُسقط شرعية الحكومات العربية.
ما يوصلنا بالنتيجة إلى أنه ليس هناك رغبة واضحة لدى الدولة للتخلي عن الوهابية أو استبدالها – في المدى المنظور على الأقل -، وذلك لأنها تمثل مصدراً مهماً للشرعية، ولأن الوهابية التقليدية تُستخدم لقمع ومحاربة التوجه الراديكالي لدى الوهابية الجهادية، من خلال دعم مؤسسات الدولة الدينية مثل هيئة كبار العلماء. وكل ما يحدث هو المزيد من التشذيب وتقليم الأظافر، إلى جانب محاولة إيجاد وهابية أكثر قدرة على تلبية متطلبات المرحلة الحالية.
المجتمع السعودي والتعاطف مع «داعش»
محمد الصادق
لأنَّنا نعيش مرحلة، غير مسبوقة، من الكسل في التعاطي مع الظواهر الاجتماعية والسياسية، ساعدت في بروزها قنوات الدعاية السياسية ووسائل التواصل الاجتماعي المنتشرة كالفطريات، فقد ظهرت قراءات تنضح بمحتوى استشراقي عن المجتمع السعودي؛ لكونه مجتمعاً «وهابياً» منغمساً في محافظته. وقد جعلته تلك الدعاية، ليس فقط متعاطفاً مع الجماعات الجهادية، بل «مفرخة للدواعش» في المشرق العربي.
لا نشكّ لوهلة، أنّ اعتماد الدولة السعودية على الإيديولوجيا الدينية لتحصيل المزيد من المشروعية، واتكاءها على مؤسسة دينية ضخمة لتثبيت أركان النظام، وتوطيد دعائمه، من خلال علاقات أفراد تلك المؤسسة، المباشرة، مع الجمهور، قد عزز من مكانة الدعوة الوهابية في المجتمع، ورفع من حظوتها لدى السلطة، كما لدى شرائح اجتماعية كبيرة في المنطقة الحاضنة للسلطة المركزية وللعقيدة الوهابية، ليس بالضرورة عن قناعة تامة بها، أو للقوة المادية التي استخدمت عند تأسيس الدولة، لكن قد تكون لأسباب نفعية صرفة. فهناك الكثير من الأشخاص لا تربطهم باللحية الكثيفة والثوب القصير سوى الوظيفة.
أحيانًا، تبدو تلاوة البديهيات هي أهم ما يجب التركيز عليه، لذا نودّ تذكير بعض المُنساقين خلف السرديات الاستشراقية عن الوهابية، بأنه لم تعد هناك وهابية صافية كما كانت عليه عند نشأة الدولة السعودية الأولى، وأن الوهابية، بسبب تحديث الدولة السعودية، مرت بمراحل جعلتها تتحوّل إلى سلفيات متعددة، ومتنافسة، وأحياناً كثيرة متصارعة.
ففي العقود الثلاثة الأخيرة حدثت الكثير من الصراعات داخل الحالة الدينية في السعودية، تمخضت عنها «الصحوة الإسلامية» بكل تفرعاتها (السلفية الجامية، والسلفية السرورية، والسلفية الجهادية، وأخيراً السلفية الإصلاحية)، وقد تعزز انقسام هذه الكتلة، مع كل أزمة كبرى تمر بها المملكة، وليس هناك أوضح من المعركة الإعلامية التي خاضتها «السرورية» ضد «السلفية الجهادية» حول سورية؛ فكل تيار سلفي دعم فصيلاً جهادياً مختلفاً عن الآخر، وتقاتل الجهاديون السعوديون في أرض الشام. إذأ من الخطأ النظر إلى المجتمع السعودي كمجتمع وهابي، أو للسلفية ككتلة صمّاء، فضلاً عن وجود شرائح اجتماعية واسعة مناهضة للوهابية على امتداد ربوع السعودية.
المجتمع السعودي ليس مجتمعاً وهابياً، وهو بالتأكيد ليس مجتمعاً عنيفاً، بمعنى أنه لم يعتد حمل السلاح وخوض المعارك، منذ استقرار النظام السعودي وتوحيد الجزيرة العربية، إلا أن حدثاً تاريخياً مهماً قد غيّر وجهة هذا المجتمع. إنها تجربة المجاهدين العرب في أفغانستان، التي انخرط فيها آلاف الشبان السعوديين، والذين شكلوا، فيما بعد، عصباً رئيساً لتنظيم «القاعدة»، إذ كان من أبرز قياداته التاريخية الشيخ أسامة بن لادن.
أعادت هذه الحرب إلى الساحة السعودية أدبيات طواها النسيان منذ اندثار حقبة «إخوان من طاع الله»، كمفهوم «الهجرة» و«أرض الجهاد»، وقد تمت الاستفادة من هذه التعبئة الشعبية الواسعة، لخدمة أجندات سياسية لا علاقة لها لا بالدين ولا بالوطن؛ بسبب وجود التحالف الوطيد بين المملكة والولايات المتحدة، وبعيداً من أهداف المجتمع السعودي، التي كان أهمها مساعدة شعب مسلم يتعرض للقتل على يد قوات غازية، وفق الرواية المتداولة آنذاك. هنا تجدر الإشارة لمفارقة غريبة، حيث جرى تجاهل احتلال فلسطين، رغم أنها ذات قداسة إسلامية، وهي أقرب جغرافياً ووجدانياً وقومياً من أفغانستان، التي لا نرتبط معها بما يدعو إلى إرسال شبابنا للقتال دفاعاً عن ترابها.
التعاطف السعودي مع «داعش» ليس نابعاً بالضرورة من عقيدة وهابية، بقدر ماهو حالة غرائزية ثأرية تجاه صعود القوى الشيعية في الإقليم، وكذلك تضخّم شعور «المظلومية» الذي كان خصوصية «شيعية» يوماً ما، فإذا به ينتقل خلال عقد واحد ليصبح أداة «السُنية السياسية» المفضلة في التعبئة والتحشيد ضد إيران وحلفائها، والذي انعكس، بلا شك، على بيئتها الاجتماعية المتوثّبة أصلاً. هذا التعاطف في بدايته كان نتاجاً «لوعي مزور»، مردّه لكون «داعش» ينتقم لهؤلاء من تغوّل العدو التاريخي «الشيعة» في مناطق طالما اعتبرها غالب السعوديين مناطق نفوذ «سُنية»، كالعراق وسورية ولبنان، في حين أن «داعش» أوّل ما يدمّره هو التنوع الاجتماعي «السُني». وفي حالة انفلات المشاعر من عقالها، بسبب الحرب الطائفية في المشرق العربي وانخراط ايران وحلفائها في قلب المعركة، يرتفع منسوب خطاب الكراهية والعداء أكثر، ولا يمكن حينها التمييز بين موقف الوهابي المتطرّف والإسلامي المعتدل.
هل يعني هذا الكلام أن «داعش» كنظام اجتماعي وسياسي يحظى بقبول السعوديين؟ لا طبعاً، بل أكثر من ذلك، لو فكر «داعش» بالمساس بأمن السعودية سيجد نفسه محاصراً، بل وفي مواجهة مباشرة مع المجتمع السعودي، والشواهد على ذلك أكثر من أن تحصى، فكثير من محاولات السلفيين، بمختلف توجهاتهم الفكرية، للتحرك في الشارع مُنيت بالفشل الذريع، وقد سبق وأن جرّبت «القاعدة» مهاجمة السعودية عام 2003، حين شرعت بالقيام بعمليات تفجير المجمّعات السكنية في الرياض والخبر، وقد استقبلت برفض اجتماعي حازم، تسبب في ضرر كبير لصورة الجهاديين السعوديين بين الناس.
من لا يفهم طبيعة المجتمع السعودي يتجاهل تاريخاً طويلاً من عدم حماسة هذا المجتمع لأيّ حراك في الشارع، وتحت أي شعار كان، رغبةً في الحفاظ على الاستقرار، فمنذ حرب الخليج الثانية 1991. وهذا المجتمع لديه ممانعة شديدة لتحويل المطالب الإصلاحية، مهما كان مصدرها، لحراك على الأرض قد يهزّ استقرار النظام، ما يظهر أن العقل الجمعي لهذا المجتمع يُثمن الاستقرار، والرخاء النسبي، الذي وفّره انتعاش أسعار النفط، ما يجعله راغباً برؤية إصلاح من داخل النظام لا من خارجه. فعلى الرغم من حالات التذمر الشعبي على مواقع «التواصل الاجتماعي» والدعوات التي يقوم بها ناشطون من حين لآخر، لتذكير الحكومة بسوء الخدمات، وضرورة الإصلاح، فإنّ أياً من هذه الدعوات، للنزول إلى الشارع، لم تحظ بدعم شعبي كبير، وتجربة «الصحوة الإسلامية»، إبان حرب الخليج، لم تنجح في تنظيم تظاهرة، إلا في مدينة بريدة، ولم يشارك فيها سوى بضعة آلاف، ولم تستمر لأكثر من أيام معدودة. وأخيراً، الفشل الذريع للدعوة لـ«ثورة حنين» آذار 2011، رغم مشاركة الآلاف على صفحة «الفايسبوك» إلّا أنها لم تلقَ استجابة شعبية. مشكلة من يتحدثون عن وجود بيئة حاضنة لـ«داعش» داخل السعودية، هو تصورهم أن شرط وجود هذه البيئة هو شرط ديني/ ثقافي، يتمثل في وجود مناهج التعليم الوهابية، وتربية السعوديين على الأفكار الوهابية، ولذا يفشلون في فهم سبب وجود حاضنة شعبية لـ«داعش» في العراق وسوريا، حيث لم يخضع سكان هذه المناطق لتربية وهابية.
الحاضنة الشعبية تنتجها الظروف السياسية والاقتصادية، وفي حالة «داعش»، تتوافر ظروف سياسية واقتصادية تساعدها في تكوين حاضنة لها في العراق وسوريا، لأسباب متعلقة بانهيار سلطة الدولة المركزية، والانقسام الطائفي والأهلي الحاد، وحلول جماعات خارج الدولة محل الدولة في رعاية مجموعات سكانية معينة، وهذا ما يسمح لـ«داعش» وغيرها بتمثيل جماعات أهلية في الصراع السياسي ضد جماعات أخرى، أما في الحالة السعودية، فسلطة الدولة المركزية متينة، والأوضاع الاقتصادية مستقرة أكثر من دول «الهلال الخصيب»، والحاضنة الشعبية قد تكون موجودة في بعض المناطق بشكل محدود، لكن الغالبية ستفضل الاستقرار على استقبال «داعش»، حفاظاً على مكاسبها الاقتصادية التي ما زالت قائمة.
إن الإحصاءات الكثيرة التي تقول بأن المجتمع السعودي مؤيد لـ«داعش» أقل ما يقال عنها إنها مُضللة، وحالة التعاطف التي كانت مع «داعش» في بداية دخوله سورية كانت تعكس حالة غرائزية أكثر من كونها إعجاب بالنموذج الداعشي في الحكم. الدعوة الوهابية في حالة انكماش، والمجتمع السعودي، وإن كانت فيه جماعة حاضنة وداعمة للسلفية الجهادية في الخارج، إلا أنه حتماً لن يستقبل «داعش» بالورود لو فكر في مهاجمة السعودية.
«داعش» وهابي أم إخواني؟
أحمد الجنيدل
يبدو «داعش» كابن لقيط تحاول التيارات الإسلامية التبرؤ من نسبه، والادعاء أن ولادته كانت نشوزاً عن منهج تيارات الإسلام السياسي. في المقابل، أغرى «داعش» الكثير من المثقفين بالهجوم على التيارات الفكرية، باعتباره ابناً لهذا الفكر أو ذاك. فمثلاً كتب عبدالله بن بجاد مقالاً يحاول فيه الإثبات أنّ «داعش» من نسل «الإخوان»، ومقابل ذلك جاء الشيخ حاتم العوني ليؤكد أن العدّة الإيديولوجية التي يستخدمها «داعش» متطابقة إلى حد كبير مع الوهابية.
هنالك ملاحظتان حول من حاولوا الادعاء أن «داعش» أخواني أو وهابي:
1- إنّ الكثير من التحليل يأتي في سياق الكيدية السياسية، في محاولة إدانة هذا التيار أو ذاك، واستخدامها في الحرب القائمة بين المحاور في المنطقة.
2- التصوّر بأن الوهابية والفكر الأخواني كانا دائماً يسيران على خطين متوازيين ولم يتقابلا أو يتقاطعا في مراحل تاريخية مختلفة.
هذا التحليل يعاني من قصور كبير، وهو عدم الانتباه إلى التمفصلات والتقاطعات الكثيرة التي حدثت بين «الإخوان» والوهابية، وأنّ الكثير من الأفكار، المؤسسة لكل تيار، تسرب إلى التيار الآخر، وفي الحقيقة لم يكن هذا على مستوى الفكر المجرد فقط، بل حتى على مستوى الشخصيات. فالعديد من الأشخاص لم يجدوا تناقضاً بين كونهم إخواناً ووهابيين، واستطاعوا أن يدمجوا بين الفكرين والإيديولوجيتين في إطار واحد، والتيار «السروري» في السعودية (تيار السلفية الحركية الذي ينسب للشيخ محمد سرور زين العابدين) هو مثال جيد على ذلك، لأنه بمجمله عبارة عن التقاء بين العقيدة الوهابية والفكر الإخواني.
إنّ البحث في البنية الفوقية أو في المَعِين الإيديولوجي الذي يستقي منه تنظيم «داعش» أفكاره، ويبني عليه أفعاله ليس بحثا ترفياً، وليس القصد منه الادعاء أنّ هذه الإيديولوجيا هي سبب انبعاث ظاهرة «داعش»، لكن هدف الحديث عن إيديولوجيا «داعش» ومصادرها يتمثل في أمرين: الأول هو في فهم نوع الشرعية الإيديولوجية التي تصبغ قرارات «داعش» السياسية، فكلّ حراك سياسي يحتاج إلى خطاب يشرعن أفعاله عند مريديه، والمصلحة السياسية وحدها لا تكفي لذلك، وفي هذا السياق، حتى وإن كانت المصلحة السياسية موجودة، فإن الإيديولوجيا ستكون مهمة جداً لإسباغ الشرعية على الفعل. فرغم أن هتلر كانت لديه مصلحة سياسية ليتعامل مع اليهود كما تعامل معهم لكن لا يمكننا تصور هذه الأفعال من دون الإيديولوجيا النازية وصراع الأعراق. وكذلك «داعش» فهنالك وراء عدد من سلوكياته مصالح سياسية واقتصادية، لكنه يحتاجون إلى الإيديولوجيا الإقصائية لإقناع أتباعم وجمهوره بشرعية هذا الفعل. وربما يكون الدين، في سياق معين، أنجع وسيلة لإضفاء الشرعية على أكثر أفعال الإنسان وحشية وإجراماً. يقول سكوت هيبارد «إن الدين يعطي رخصة أخلاقية للسياسي ليفعل ما يشاء».
السبب الثاني الذي يجعل الحديث عن إيديولوجيا داعش مهماً هو أنّه ثمّة أفعال لهذه الجماعة السياسية يكون دافعها الأوضح هو تطبيق الإيديولوجيا التي تتبناها، والدين كما تفهمه، إذ إنها تعترف صراحة، مثلاً، بأن سبب إجبارها الأيزيديين على الإسلام، وسبي نسائهم، هو أنها تأخذ بقول جمهور الفقهاء الذين لا يجيزون أخذ الجزية من المشركين، وإنّما فقط من أهل الكتاب، فالمشركون ليس لهم إلا السيف أو الإسلام ونساؤهم تُسبى، عكس نساء الطائفة المسلمة الممتنعة، حيث لا يجوز سبيهنّ. فكما قلنا: إنّ الهدف من البحث في إيديولوجيا «داعش» ليس الجواب عن سؤال: لماذا انبعثت ظاهرة مثل «داعش»؟ ولكنه للجواب على سؤال: لماذا يتشكل «داعش» بهذا الشكل ويتصرف على هذا النحو؟
إنّ خطر «داعش» وسرّ قوته يكمن في أنه استطاع الجمع بين أسوأ صفات «الإخوان» والوهابية؛ فهو يستخدم خطاب الجهاد العالمي، ويجعل نفسه قبلة لكل المسلمين، الحالمين بزمان العزة والمجد، كما يستخدم المنظومة العقائدية والفقهية الوهابية في عملية بناء دولته.
خطاب الجهاد العالمي وسردياته الكبرى وحججه الأساسية، وُلد من رحم فكر «الإخوان المسلمين»، ولم يكن هذا الخطاب غريباً على «الإخوان»، فالشيخ حسن البنا يؤكد، في ردّه على الوطنية المحرّمة، «إننا نعتبر حدود الوطنية بالعقيدة، وهم يعتبرونها بالتخوم الأرضية والحدود الجغرافية، فكل بقعة فيها مسلم يقول (لا إله إلا الله محمد رسول الله) هو وطن عندنا له حرمته وقداسته وحبه والإخلاص له والجهاد في سبيل خيره».
فالعالم الإسلامي كله وطن في تصور حسن البنا، ويجب الجهاد في سبيله، وخطاب الأممية الإسلامية هذا، تولّد منه خطاب الجهاد العالمي، وقد استخدم «الإخوان المسلمون» هذا الخطاب لدعم الجهاد الأفغاني في الثمانينيات، ولدعم الجهاد في البوسنة، وكذلك دعموا الجهاد الشيشاني، ما جعل روسيا تضع «الإخوان» في قائمة الجماعات الإرهابية. لم يتوقف تورّط «الإخوان» في حركة الجهاد على الدعم الإيديولوجي، وإسباغ الشرعية الدينية على هذا النوع من الحروب، بل أكثر من ذلك، فقد كان العديد من شخصيات الجهاد، التي ذاع صيتها في تلك الفترة، منتمية إلى تنظيم «الإخوان». وبحسب الباحث الفرنسي ستيفان لاكرو فإنّ عبدالله عزام، أحد أهم شخصيات الجهاد الأفغاني، كان عضواً في جماعة «الإخوان» بل إن أسامة بن لادن نفسه، كان عضواً في جماعة «إخوان الحجاز»، وهي أحد فروع جماعة «الإخوان المسلمين» في السعودية، وأيضاً سمير السويلم، المشهور باسم «خطاب»، قائد المجاهدين في الشيشان، كان «إخوانياً» هو الآخر، وبحسب تقارير عدة، فإن زعيم تنظيم «القاعدة» الحالي أيمن الظواهري، كان قد اعتُقل بسبب انتمائه لجماعة «الإخوان المسلمين».
«الإخوان المسلمون» استخدموا خطابهم الإيديولوجي لدعم الجهاد في مرحلته الأفغانية، وكانوا أهم فاعل فكري في دعم هذا الجهاد، وظاهرة مثل «داعش» لا يمكن تصور بروزها من دون هذا التراكم، الذي امتدّ طوال أربعة عقود من تجربة العمل المسلّح، في إطار نصرة المسلمين ضد «الكفّار»، وأيضاً من دون خطاب الجهاد العالمي الذي كان أداة للتجنيد في السابق، وفي الوقت الحاضر عند «داعش»، وأيضاً ادعاء أنّ كلّ بقعة فيها مسلم، كما يقول حسن البنا، هي وطن للمسلمين يجب أن يجاهدوا في سبيله، كانت هي الفكرة التي تمحورت حولها كل جماعات الجهاد العالمي، ومنها «داعش».
في المقابل، خطاب الجهاد العالمي ليس موجوداً عند الوهابية، وتحديداً عند الوهابية الأولى، قبل عصر الدولة السعودية الثالثة، لأن وهابيي تلك الفترة يعتبرون المسلمين خارج الدعوة الوهابية، إما «كفاراً» أو «جهلة» يجب تعليمهم العقيدة قبل نصرتهم العسكرية، لذا كان موقف السرورية رافضاً لدعم الجهاد في أفغانستان بسبب خلفيتهم الوهابية، فالشيخ سفر الحوالي، كان ضد ذهاب الشباب إلى أفغانستان بحجة أن الأفغان «ماتريدية» وليسوا من أهل السنة والجماعة، وأنهم يعانون من مشكلة توحيد وعقيدة، وليس من مشكلة أرض وتراب واحتلال. وفي هذا السياق أيضاً نفهم السجال الإيديولوجي الذي كان يدور داخل الحالة السلفية حول شرعية نظام طالبان، والذي استفاد مؤيدو شرعيته من عملية تفجير تمثال بوذا، ليثبتوا صفاء عقيدة طالبان ومحاربتها للوثنية، وبالتالي ليؤكدوا صوابية الهجرة إليها.
وفي نظرنا أن خطاب الجهاد العالمي وإيديولوجيته، غير منسجمين مع التراث الوهابي وإنّما مع «الإخواني»، ولذلك يقول الباحث النروجي توماس هيغهامر: «لا ريب في أن الدعوة إلى الوحدة الإسلامية، في عهد الملك فيصل، كانت مثيرة للسخرية بعض الشيء بالنظر إلى عداء العلماء الوهابيين التاريخي للمسلمين من غير الوهابيين، إذ إنهم إلى مستهل القرن العشرين لم يعتبروا في الغالب غير الوهابيين مسلمين أصلاً». ومن هنا يتضح الفرق بين نوعية الدعم والنصرة اللذين يحرّض عليهما خطاب «الإخوان» الإيديولوجي، وبين الدعم والنصرة اللذين من الممكن أن يتسامح معهما الخطاب الوهابي. فالخطاب الوهابي يشترط أن تكون السيطرة لعقيدته ومذهبه، فإما أن تتوسّع الجماعة الوهابية نفسها، وبالتالي تكون هي المسيطرة على الإقليم، أو تدعم جماعة أخرى تؤمن بالمذهب الوهابي وولاؤها له، وتحارب معالم الشرك. لذلك كانت المؤسسة الدينية الرسمية في السعودية، إبان حرب أفغانستان، تصرّ على الحكومة السعودية أن يكون الدعم موجهاً إلى جميل الرحمن وجماعته، لأنه أكثر قرباً للوهابية وتعاليمها.
أمّا عن الارتباط الإيديولوجي بين «داعش» والوهابية، فمن الواضح أنّ «داعش» يستخدم المفاهيم الوهابية على مستوى المنظومة العقدية والفقهية. على مستوى العقيدة يقارب الاستخدام السياسي للتكفير عند «داعش» استخدام الشيخ محمد بن عبدالوهاب له، فالتكفير عنده لا يكون فقط بسبب التصورات العقدية والأفعال الفردية، لكن حتى وإن كانت الجماعة المختلفة عن «داعش» مقتنعة تماماً بالدعوة العقدية، إلّا أنها لم تنضم تحت إمرة «داعش» ودولته فهي «كافرة»، إما لأنها موالية لـ«الكفار» أو لأنها ترفض مساعدة المسلمين، الذين هم هنا أعضاء جماعة «داعش». هذا النمط من التكفير السياسي لم يكن غريباً على الشيخ محمد بن عبدالوهاب، فرغم اقتناع أهل منطقة القصيم بدعوة محمد بن عبدالوهاب، وانضمامهم إلى الدولة السعودية، إلا أنّ أهل قرية الزلفي رفضوا الانضمام للدولة الوليدة، فأرسل الشيخ محمد بن عبدالوهاب رسالة إلى أهل القصيم يحذرهم فيها، أنهم إن لم يعادوا ويبغضوا جارتهم قرية الزلفي، فلن ينفعهم توحيدهم في شيء. هذا التكفير السياسي، والذي يتمحور حول الولاء والبراء، هو نفسه الذي يستخدمه «داعش» مع خصومه من الجماعات السياسية الإسلامية المختلفة عنه، والتكفير هنا يميز أعضاء «داعش» عن غيرهم، بوصفهم هم المسلمون، الذين يتقمصون دور الصحابة الأوائل، وينشرون الدين من جديد، لذلك يحتاجون إلى التكفير في تأكيد هويتهم مقابل الآخرين، وشدّ عصب جماعتهم، ثم استخدامه محفزاً للقتال، وهو أمر مشابه لما قامت به الوهابية الأولى، التي عملت على فتح المناطق الجغرافية في الجزيرة العربية، وضم أهلها إلى «الإسلام»، وإخراجهم من «الجاهلية».
على صعيد آخر لم يكن بناء الأضرحة والمساجد على القبر قضية إخوانية، بل كان قضية وهابية بامتياز، وكان «الإخوان» متصالحين معها أو رافضين لها، لكن ليس لدرجة السعي إلى تغييرها بالعنف كما فعلت الوهابية، وكما يفعل «داعش» الآن. جماعة «داعش» أيضاً قريبة من الوهابية في المنظومة الفقهية، فالوهابية حنابلة، بينما «الإخوان» لديهم تنوع واسع في تناول الفروع الفقهية، وليسوا متحمسين لقول فقهي دون آخر، ويجيزون أخذ كل قول فقهي طالما هو موجود في التراث، ولا عدائية شديدة لديهم مع أتباع المذاهب المختلفة. لكن عند «داعش» فالحنبلية هي مذهب الدولة كما يظهر، وهو يجبر الناس على ممارسة شعائره الدينية من خلال هذا المذهب، فمسألة كتغطية الوجه هل هي جزء من الحجاب الشرعي أو لا؟ نقاش فقهي شهير، مجمل الحنابلة فيه مع وجوب تغطية الوجه، وبقية المذاهب يرونه غير واجب، لكن «داعش» يأخذ بالقول الحنبلي ويجبر النساء على تغطية الوجه. وكذلك مسألة صلاة الجماعة، فالحنابلة هم من رأوا وجوبها، بينما بقية المذاهب قالوا إن صلاة الجماعة سنة. لكن «داعش» يأخذ بقول الحنابلة ويجبر أصحاب المحال التجارية على الإغلاق وإقامة الصلاة جماعة.
وبهذا يكون «داعش» مثل الوهابية، لأن علماء الوهابية كانوا حنابلة، طبعاً من دون أن نغفل عن توزيع «داعش» كتب الشيخ محمد بن عبدالوهاب، وترديدها المفردات الوهابية حول نواقض الإسلام، والولاء والبراء وغيرها، وحديث أبو عمر البغدادي، أمير الدولة السابق، عن عقيدة الدولة في إقامة الدين ونشر التوحيد «الذي هو الغاية من خلق الناس»، ما يجعل «داعش» دولة رسالية على النمط الوهابي.
إنّ البحث في إيديولوجيا «داعش» على غاية من الأهميّة ليس لتفسير نشوء هذه الدولة، الذي تفسره مجموعة من العوامل السياسية والاقتصادية، لكن لفهم تصرفاتها وما يعطيها الشرعية الضرورية التي تحتاجها كل حركة سياسية في ممارساتها، ونحن عندما نربط إيديولوجيا «داعش» بالوهابية أو «الإخوان» فليس المقصود إدانة أفراد بعينهم ينتمون لهذا الفكر أو ذاك، بل المقصود فهم الجوانب العقدية والفكرية، التي تعطي المسوغ الشرعي لحركةٍ مثل «داعش»، وتجعل الكثير من الناس ينتمون إليها ولا يعارضون جرائمها.
«داعش» وريث «الإخوان» والوهابية على حدٍ سواء، وامتداد طبيعي لتراكمات كثيرة وتمفصلات عديدة مرّ بها الوسط الإسلامي إبان حقبة الجهاد العالمي، وإن كانت الذخيرة الإيديولوجية للتنظيم وهابية بشكل واضح.
الأثر الإخواني بارز في تنظيم «القاعدة»، وهو يختلط في التنظيم مع إرثٍ وهابي، أما في «داعش» فالمعتقد الوهابي طاغٍ بوضوح، لكن هذا لا ينفي أثر أفكار «الإخوان» حول الجهاد العالمي، ومساهماتهم في التجارب الجهادية المتعددة، وأن الجهاد العالمي كان هو الجسر الموصل إلى تجربة «داعش». التنظيم الذي يستخدم خطاب الجهاد العالمي، وشوق «الإخوان» والحركات الإسلامية لإحياء «الخلافة»، بعد سقوط العثمانيين، في إعادة إنتاج الوهابية الأصلية.
الوهابية بلا أنياب
بدر الإبراهيم
شكلت معركة السبلة عام 1929، بين الملك عبدالعزيز وعلماء الدين المنضوين تحت لوائه من جهة، وإخوان من طاع الله (الجيش العقائدي المكوّن من البدو، الذي ساهم بتوحيد المملكة تحت قيادة الملك عبدالعزيز) من جهة أخرى، مفاضلة بين وهابيتين: وهابية أصلية، تلتزم النصوص المؤسِّسَة للوهابية، وأخرى براغماتية، تعدّل التعاليم الوهابية بما يتناسب مع الواقع. اختلف العلماء المساندون للمك عبدالعزيز مع «الإخوان» في أمور عدة، منها تعامل الدولة الناشئة مع البريطانيين، ورفض استكمال الجهاد خارج الحدود، وأدت المواجهة إلى انتصار النهج الوهابي المعدّل، لكن الوهابية الأصلية لم تختفِ، واليوم يمثل «داعش» إحدى أبرز تجلياتها.
لم تكن الوهابية المعدّلة شريكة في الحكم مع الملك عبدالعزيز، على غرار الشراكة التاريخية بين الشيخ محمد بن عبد الوهاب، والإمام محمد بن سعود، والتي أدار من خلالها الطرفان معاً الدولة وشؤونها، بل إن الوهابية المعدّلة وعلماءها كانوا تحت نفوذ وسلطة الملك عبدالعزيز، والأخير كان هو السلطة الأعلى، وهو يمنح العلماء وأتباع الوهابية نفوذاً يتلاءم مع التوجهات الإيديولوجية للدولة، لكن هؤلاء ليسوا شركاء في الحكم. إعلان قيام المملكة السعودية، بهذه الصيغة، التي تجعل من عبد العزيز ملكاً، وصاحب السلطة الأعلى، كان بداية غياب النموذج الوهابي التقليدي عن الحكم، القائم على شراكة كاملة بين الشيخ والأمير.
مع ذلك، استمر نفوذ الوهابية، وسمحت السلطة السياسية للمتدينين الوهابيين بنشر أفكارهم، واستخدام إمكانات الدولة لذلك، ضمن حدود ترسمها السلطة نفسها، وشهد تاريخ الدولة السعودية الثالثة وجود شخصيات دينية ذات أثر مهم، وكان للشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، مفتي المملكة حتى وفاته عام 1969، نفوذ كبير، إذ كان يشرف على القضاء، ويحاسب حتى بعض المسؤولين، وقد أشرف على رئاسة تعليم البنات، وعين رؤساءها، كما أشرف على الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة. ربما يكون الشيخ محمد بن إبراهيم آخر علماء الوهابية المتنفذين بهذا الشكل ضمن الدولة، فبعد وفاته دخلت الوهابية في مرحلة جديدة من الاحتواء.
تعرضت الوهابية المعدّلة لضربتين جعلتاها أقل فاعلية بكثير في المجال العام، الأولى كانت عبر توسّع الجهاز البيروقراطي للدولة، وضمّه مجموعات من الموظفين التكنوقراط غير الوهابيين، والذين لا يرون أن من مهماتهم تعزيز الإيديولوجيا الوهابية من خلال المؤسسات التي يعملون بها. أما الضربة الثانية فكانت بإدخال الوهابيين أنفسهم إلى جهاز الدولة البيروقراطي، ومأسسة الوهابية بضم العلماء الوهابيين إلى مؤسسات الدولة، وتحويلهم إلى موظفين إداريين يقومون بمهمات محددة، ضمن صلاحيات مرسومة للمؤسسات التي يعملون بها. بعد وفاة الشيخ محمد بن إبراهيم، قام الملك فيصل بإنشاء هيئة كبار العلماء عام 1971، والتي أنيطت بها شؤون الفتوى، ويُختار أعضاؤها بأمر ملكي (لم يعد منصب المفتي العام بعد وفاة الشيخ ابن إبراهيم إلى الواجهة إلا عام 1993 بتعيين الشيخ عبدالعزيز بن باز مفتياً عاماً للمملكة)، كذلك أنشأ الملك فيصل مؤسسة تحمل اسم «الهيئة القضائية العليا» لتحل محل رئاسة القضاة، التي كان يتولاها الشيخ ابن إبراهيم، وقد تحولت بعد خمس سنوات إلى «مجلس القضاء الأعلى»، وباتت رئاسة القضاة تابعة لوزارة العدل. هكذا، صارت الوهابية ضمن نطاق جهاز الدولة البيروقراطي، تعمل مؤسساتها مثل بقية المؤسسات، تحت إشراف كامل من السلطة السياسية.
أحد تمظهرات حركة جهيمان العتيبي، التي قامت باحتلال الحرم المكي عام 1979، هي الاعتراض على ضعف تطبيق الشريعة في الدولة، ومداهنة العلماء للسلطة السياسية، وقد استعادت الحركة في ذلك، خطاب «إخوان من طاع الله»، في محاولة للعودة إلى الوهابية الأصلية، التي فرّط علماء المؤسسة الرسمية بها. وتمكن ملاحظة نقد العلماء وركونهم إلى الدعة والمسكنة، وتخاذلهم عن مطلب «قيام السلطان مع الدين»، في رسائل جهيمان العتيبي. تمرّد جهيمان، ومن معه، على احتواء الوهابية وتشذيبها والسيطرة عليها من الدولة، ولم تكتب نهاية الحركة نهايةً لموجات التمرد الرافضة للوضع القائم، والراغبة في استعادة مكانة الوهابية وسطوتها.
في الثمانينيات منحت بعض الظروف الداخليّة، كما الخارجية المتصلة بالصحوة الدينية التي عمّت المنطقة، والقرار السعودي بمواجهة المدّ الثوري الإيراني، والجهاد الذي دعمته المملكة في أفغانستان، الفرصة لتعزيز التيارات السلفية، وخلق ظاهرة سلفية شعبية، عُرِفت بـ»الصحوة الإسلامية»، تمّ تمكينها من استثمار مؤسسات الدولة للترويج لأفكارها، فانتعشت التيارات السلفية بأنواعها، وأصبحت تتمتع برصيد شعبي كبير. إثر حرب الخليج الثانية، ومعارضة مشايخ الصحوة لاستقدام القوات الأميركية، تحول هذا التيار الدعوي إلى معارضة سياسية بين 1990- 1994، وظهر نقد من مشايخ تيار «الصحوة» للعلمانيين داخل مؤسسات الدولة، ولما اعتقدوه نفوذاً لهم في دولة يفترض بها تطبيق الشريعة ومحاربة العلمانية، وطال النقد المؤسسة الدينية الرسمية، ممثلة بهيئة كبار العلماء، بعد موافقتها على قرار السلطة بالاستعانة بالقوات الأميركية.
المعارضة الصحوية صاغت مذكرة بمطالبها أسْمَتها «مذكرة النصيحة»، تطلب فيها من السلطة السياسية مطلباً رئيساً، يتكرر طوال فقرات المذكرة، وهو إعادة الاعتبار لدور العلماء ورجال الدين، وتمكينهم من الإشراف على كامل أنشطة الدولة وأجهزتها، أي أن المطلب الرئيس للمعارضة الصحوية كان العودة إلى الشراكة التاريخية بين الشيخ والأمير، والتي تبين لهم أن صيغتها القديمة انتهت، وأن السلطة السياسية حجّمت الوهابية وجعلتها تحت سيطرتها. اختلفت «الصحوة» عن جهيمان والقاعدة، فلم تتجه إلى حركة تمرد مسلحة، لكنها عملت على حشد الناس لمطالبها، وانتهى الأمر باعتقال رموزها من المشايخ والنشطاء عام 1994. من جملة القرارات التي اتخذتها الدولة لاستيعاب الحراك الصحوي مطلع التسعينيات، استحداث وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد عام 1993، وكان الهدف الرئيس من إيجاد هذه الوزارة المزيد من ضبط المجال الديني، وسحب ما منح للصحوة من حرية في الحركة والتصرف داخل مؤسسات الدولة، أو باستخدام المنابر الدينية، وأصبحت الوزارة الجديدة تضبط أوضاع المساجد وأئمتها وحلقات تحفيظ القرآن والأنشطة الدينية بالعموم، وهكذا فإن الاتجاه نحو المزيد من المأسسة، قلَّص نفوذ الوهابية أكثر، وأكد بشكل أكبر سطوة السياسي على الديني في السعودية.
كان لأحداث الحادي عشر من أيلول أثرها، الذي تمثل في مزيد من الضبط وتقليص الوهابية من قبل السلطة السياسية، فحصلت مراجعة للمناهج الدينية، وأغلق بعض المؤسسات الخيرية مثل «مؤسسة الحرمين»، للاشتباه بتمويلها الإرهاب. كانت أعمال «القاعدة» داخل السعودية، بداية من عام 2003، امتداداً لحركة نزع الشرعية الدينية عن الدولة، لتخاذلها في تطبيق الشريعة، واتساقاً مع مبادئ الوهابية الأصلية، ضد الوهابية المعدّلة، واليوم يمثل «داعش» الامتداد الأكثر وضوحاً للوهابية الأصلية، في وقت تغيّر السعودية الكثير داخل الوهابية. وخلال السنوات العشر الماضية واصلت الدولة عملية تكييف الوهابية مع احتياجاتها، ما جعل الوهابية الحالية تتباعد بشكل أكبر عن أصولها، مع احتفاظها ببعض الملامح العامة.
قبل ما يقارب العامين زار بعض المشايخ السلفيين (من بينهم الشيخ عبدالله المحيسني الذي ذهب بعد ذلك إلى سوريا لمناصرة الحالة الجهادية هناك) الديوان الملكي، ووقفوا أمام بوابته، من دون أن يُسمح لهم بالدخول، وقد جاؤوا للتفاهم مع المسؤولين في الديوان، والاعتراض على ما اعتبروه متغيرات أحدثتها السلطة تتعارض مع الدين. هذا المشهد ومطالب المشايخ، يعبران عن التحجيم الذي أصاب الوهابية خلال السنوات الماضية، يضاف إليه ترهل المؤسسة الدينية الرسمية، بخاصة بعد غياب شخصيات وازنة فيها مثل الشيخين: ابن باز، وابن عثيمين.
هذا الاستعراض مهم لتأكيد قدر التبسيط الذي يحمله الحديث عن سيطرة وهابية على جهاز الدولة في السعودية، أو عن شراكة كاملة بين المؤسستين الدينية والسياسية، وتالياً قصور التحليلات التي تُبنى عليه. وفي نفس الوقت الذي تُقلّم فيه أظافر الوهابية، يبدو أيضاً أنها ستظل إحدى أهم مصادر الشرعية بالنسبة للدولة، ولأسباب عديدة يصعب توقع الانتقال منها إلى إيديولوجيا مغايرة في الوقت الحالي، لكن تهذيبها وتكييفها مع احتياجات الدولة سيبقى قائماً.
المصدر: «الأخبار» اللبنانية
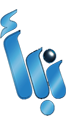 قناة نبأ الفضائية نبأ
قناة نبأ الفضائية نبأ



