السعودية/ يطرح الكاتب اللبناني ربيع بركات في مقال نشرته صحيفة "السفير"، سؤالا بات في عهده السياسيين والاقتصاديين حول العالم وهو "كيف يمكن لحرب اليمن، التي تتقدم فيها السعودية مع حلفائها ميدانياً ببطء، أن تسهم في تفجير جملة من ملفات المملكة دفعة واحدة؟"
ويوضح الكاتب، ننطلق من حقيقة أن الحرب كانت أكثر كلفة مما قٌدّر لها أن تكون (مالياً وعسكرياً وأمنياً)، وأن شوطاً مديداً ما زال متوقعاً قبل الوصول إلى حسمها، للقول إنها تضافرت مع عوامل تتصل بتحولات دولية وأخرى تخصّ الاقتصاد العالمي، لا تصب في مصلحة الرياض على المدى المتوسط.
تركز هذه المقالة، باختصار، على ثلاثة عوامل في طور النمو يمكن البناء عليها لاستنتاج عدم قدرة الرياض على السير في نهج اندفاعتها الراهنة لفترة طويلة، علماً أن كلاً من هذه العوامل يستأهل عرضاً خاصاً: انعكاس تراجع الإنفاق الداخلي السعودي على بنية علاقات القوة داخل المملكة، تقلّص دور النفط كسلاح استراتيجي، واحتدام الصراع بين جهاز المملكة الحاكم والتيار السلفي الجهادي.
1ـ يُتوقع أن يلامس عجز الميزانية السعودية مع نهاية العام الحالي نسبة 20 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، فيما كان الفائض في الميزانية يتجاوز 20 في المئة أحياناً خلال السنوات الماضية. في الأرقام، انخفض احتياط النقد الأجنبي لدى المصرف المركزي السعودي بأكثر من 10 في المئة ما بين منتصف 2014 ومنتصف 2015 (من 746 مليار دولار إلى 669 مليار دولار). وقد حذر تقرير لـ «صندوق النقد الدولي» الشهر الماضي من تآكل احتياطات المملكة على المدى المتوسّط في حال عدم تكيّفها مع تراجع أسعار النفط العالمية وتنويع مصادر دخلها الذي يعتمد بغالبه على الإيرادات النفطية. والمعروف عن السعودية أنها أكثر قدرة من غيرها على تحمّل الاستنزاف المالي لوفرة احتياطاتها النقدية. وهي تتفوق لهذه الناحية بأشواط على إيران، الضعيفة في هذا المجال، مثلاً. غير أنها لم تعُد قادرة تماماً على الموازنة بين تقليص الاستنزاف في خزينتها ومتطلبات البيت الداخلي السعودي الذي يحتاج إلى ضخ أموال ومسكّنات جديدة على ضوء أربعة أمور: ترهّل الأمن الحدودي وتداخل المناطق الجنوبية الغربية مع مجريات الحرب على اليمن، قلق سكان المنطقة الشرقية من تكرار الهجمات الانتحارية مع ضبط المزيد من خلايا «الجهاديين» في المملكة، استمرار التوتر الصامت بين جناحيْ النظام منذ وفاة الملك عبد الله، وفتح الأسواق السعودية أمام الخارج تجاوزاً لأصحاب الوكالات (أثرياء المملكة الذين يشكلون مراكز نفوذ اقتصادي فيها). في العام 2011، مع انطلاقة «الربيع العربي»، أقرّت الرياض خطة بقيمة 133 مليار دولار لرفع رواتب موظفيها وزيادة التقديمات الاجتماعية. هل تستطيع المملكة اليوم أداء دورها «الريعي» بالقدر ذاته؟ استشارتُها مؤسساتٍ دولية لخفض النفقات مؤخراً تفيد عكس ذلك.
2ـ تخسر السعودية نفطها كسلاح استراتيجي بشكل متسارع منذ سنوات، من دون أن تعوّض هذه الخسارة بتأسيس بنية تحتية جدية لاقتصاد إنتاجي. في هذا الإطار، يتوقع تقرير صادر عن «البنك الدولي» قبل ثلاثة أشهر (حزيران 2015) أن تحافظ أسعار النفط على مستوياتها المنخفضة على المدى المتوسط. وهبوطُ الأسعار الحالي هو الثالث من حيث الحجم في العقود الثلاثة الأخيرة (بعد العام 2008 وقد كان الأكثر حدة، والعام 1986). غير أن أبرز الفوارق بين مسببات الهبوط الحالي وتلك السابقة له، أن الأخير يتصل أساساً برفع الإنتاج غير التقليدي في دول غير مصدرة للنفط (النفط الحجري shale oil في أميركا، والنفط الرملي oil sands في كندا مثلاً)، واكتشاف حقول نفط جديدة حول العالم (روسيا وأميركا وكندا وغرينلاند والنرويج في منطقة القطب الشمالي، البرازيل والمكسيك وبعض دول غرب أفريقيا في قاع البحار…)، واستحداث مصادر جديدة للطاقة البديلة (تسييل الفحم الحجري coal liquefaction في أميركا والصين وإندونيسيا مثلاً). وأهمية كل ذلك أنه يحصل في دول لا ينتمي معظمها إلى منظمة «أوبك»، وهو ما يطرح علامة استفهام حول مدى قدرة المنظمة على الاستمرار كاتحاد للمنتجين يتحكم بكميات النفط المُنتَجة والمُصدَّرة عالمياً. وبرغم وجود عوائق تحول دون استثمار مصادر الطاقة البديلة بالحد الأقصى (اعتبارات بيئية وأخرى تتصل بكلفة الإنتاج)، فالثابت أن قضية انحفاض أسعار النفط ترتبط بما هو أخطر على اقتصاد المملكة السعودية من مجرد فقاعة أو أزمة عابرة. إذ إن المسألة تتعلق بتضاؤل قدرة الرياض على استخدام سلاح النفط داخلياً (كدولة ذات نظام ريعي rentier state) أو خارجياً (للضغط على دول بعينها). بالتالي، فإن سلاح الاقتصاد بات يعتمد على المال السائل الذي يتناقص، أكثر من اعتماده على النفط كمخرون استراتيجي. وهذا تحوّل كبير بحدّ ذاته. حرب اليمن هي أوّل محطة كاشفة لتراجع تأثير سلاح النفط (رفع الأسعار لتعويض الخسائر)، ومبيّنة لضخامة الاستثمار في السلاح والاعتماد المبالغ فيه على البترول، على حساب البنية الإنتاجية.
3ـ تمارس الرياض لعبة شبيهة بتلك التي خبِرتها في أفغانستان وأسّست لولادة تنظيم «القاعدة» قبل ثلاثة عقود، لكن بخَفر هذه المرة. التدخل الروسي في سوريا دفعها إلى رفع منسوب تهديدها الكلامي (التلويح باستخدام القوة العارية مباشرة لإسقاط النظام)، وإلى غض الطرف عن دعوات «الجهاد» الصادرة داخل المملكة خلافاً لقوانينها التي تحظر ذلك، رسمياً. وقد ظهر الأمر الأخير في البيان الذي وقّعه 52 عالماً سعودياً قبل أيام ودعا إلى قتال «الروس والغرب والصفويين والنصيريين» في سوريا، وبرز في كلام بعض موقّعيه على وسائط التواصل الاجتماعي تعاطف غير مباشر مع «داعش» و «القاعدة»، حتى في الهجمات التي استهدفت المناطق الشرقية للمملكة. إذا ما حصل واتسعت أبواب «الجهاد» في سوريا، فإن الفوضى والفراغ في اليمن، أي عند الخاصرة الرخوة للسعودية، هما أكبر مُساعدَين على تشكُّل ممر يستوعب الوافدين الجدد إلى ساحات القتال، التي ستضيق في سوريا شيئاً فشيئاً وتتسع في اليمن (العملية التي تبناها «داعش» أمس ضد القوات الإماراتية في عدن من المؤشرات الأولى لذلك). غير أنهما في الوقت ذاته، أكبر خطر على المملكة التي لن تقدر على المزايدة على «الجهاديين» في دعوات الحرب ضد دول لا تملك المملكة أن تعاديها. ومع هذا الافتراق، تستفيد «السلفية الجهادية» من ظروف حربي سوريا واليمن وقرب الأخيرة جغرافياً من المملكة، لتُعيد طرح سؤال شرعية الحكم من زاويتها.
ما ذُكر أعلاه لا يعني أن المملكة تقف على حافة خطرٍ بالغ. فالرياض تمتلك عناصر قوة، والتهويل لا ينتقص من قدراتها شيئاً. غير أن السير على الخطى الراهنة نفسها قد يودي بالرياض حسابياً إلى الحافة المذكورة بعد سنوات قليلة نسبياً. النظام السعودي، بهذا المعنى، يواجه تحدياً وجودياً إن لم يُحسن إدارة العجلة في أكثر من ملفٍ وعلى غير صعيد، داخلياً وخارجياً. وعامل الوقت، خلافاً لما كان الحال عليه قبل سنتين أو ثلاث، لم يعُد حليف الرياض.
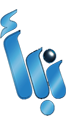 قناة نبأ الفضائية نبأ
قناة نبأ الفضائية نبأ



