السعودية/ نبأ- قالت صحيفة "السفير" اللبنانية في مقال للكاتب عبدالله زغيب، أن الرياض استشعرت تبدلاً «استراتيجياً» في الدورة الاقتصادية المحيطة بها، فأطلقت برنامج «السعودية 2030» المثير للجدل، بما فيه من «تخلّ» عن «ثوابت»، يتداخل فيها العقائدي بالتقني بالاقتصادي، فالحاجة باتت اليوم للبقاء والاستمرار، بمعزل عن الضوابط والضمانات الغربية الوازنة، وكذلك المتحكمة الى حد بعيد بآلة الإنتاج السعودية. لكن الاستشعار الأعمق، الذي بات يتحكم بنسق «التيارات» الصاعدة داخل قصور الرياض، يعدّ أكثر «ضراوة» وتهديداً لـ «نهائية» السعودية كمملكة قائمة، فـ «الرحيل» الأميركي عن منطقة الشرق الأوسط، أو بالحد الأدنى تراجع الأميركيين عن منسوب معتاد من الانخراط، كان الضامن الأساسي والمعول عليه، في إبقاء المملكة العربية السعودية كقوة عظمى بالميزان الإقليمي، ما يفرض بطبيعة الحال، «خطة» سياسية تتضمن رؤية «ثورية» أخرى، لضمان المتاح من «مكانة» للرياض، في ظل المتغيرات الحالية، القائمة على تحالفات أكثر شراسة، من أي زمن عهدته الأنظمة الخليجية منذ استقلال دولها عن الاستعمار، وحتى ما قبل ذلك.
جاءت الأخبار والمقاطع المصورة وحتى حزم «الإشاعات»، التي تناولت جلسات «حميمية» بين مسؤولين سعوديين سابقين ونظرائهم من «إسرائيل»، لتكلل القراءة الكاملة، لـ «رؤية» الرياض في مرحلة ما بعد الأميركي، أو في مرحلة الاستقطاب الحاد، او ربما بداية تشكيل تحالفات «متناقضة» في الشكل والجوهر، إنما أقدر على تقديم رافد استراتيجي للسعودية في مواجهة «الصعود» الإيراني قيد التوسع. وتدرك الرياض كما طهران، أن المرحلة المقبلة لن تكون على الإطلاق، انعكاساً لما يقال عن لقاء أميركي روسي، ورغبة مشتركة لإقفال الملفات الحامية، حيث إن تمرير الملفات هذا، لم يعد خاضعاً للحسابات «العظمى» بصورة حصرية، في ظل تنامي حجم انخراط اللاعبين الإقليميين، واعتماد الرعاة الدوليين عليهم لإعادة إنتاج رؤية خاصة بهم، وكذلك منظـــومة علاقات ومصالح ومخاوف ومخطـــطات، تتجاوز العواصم الكبرى، لما لفوضى الشرق الأوســـط الحالية من قـــدرة على «اقتلاع» الأنظمة واستبدالها بحــالات «مارقـــة»، أو بمنظومات «فوضــوية» أقل حجماً، ما يفرض حكماً قراءة جديدة تقوم على مبدأ «البقاء»، وتخــطي مرحلة الانحناء أمام عواصف «الربيع العربي».
جاءت الندوة المفتوحة لـ «معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى»، والتي جمعت رئيس الاستخبارات السعودية السابق الأمير تركي الفيصل، والجنرال الإسرائيلي المتقاعد ياكوف أميدرور، الذي شغل حتى العام 2013 منصب رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، لتشكل «بداية» أكثر وضوحاً لانطلاق مسار «تطبيعي» بين الجانبين، ينقل «العلاقة» هذه من «التابو» إلى «المنبر»، برغم لقاء الأمير تركي قبل سنوات بالرئيس السابق لجهاز «أمان» الإسرائيلي عاموس يدلين، فالجلسة الجديدة التي حملت عنوان «حديث حول الأمن والسلام في الشرق الأوسط»، ضمن مؤتمر «واينبرغ» السنوي للمعهد، تعد «الحادثة المسبقة التخطيط» الأولى، التي تلتقي فيها قيادات «سابقة» من الصف الأمني الأول، وكذلك الأقرب الى جهاز صنع القرار لدى الجانبين السعودي والإسرائيلي، بعد استضافة مجلس العلاقات الخارجية الأميركي العام 2015، الجنرال السعودي المتقاعد ورئيس «مركز الشرق الأوسط للدراسات الســـياسية والإســـتراتيجية في جدة» أنور عشقي، إلى جانب دوري غولد، الـــمدير العام السابق لوزارة الشؤون الخارجية الإسرائيلية، في جلسة مشتركة حول «التهديد» الإيراني.
لا يُفترض بلقاء يجمع اثنين من «صقور» الأجهزة الأمنية في المنطقة، أن يكون مجرد حلقة بحثية تهدف لإبراز «حسن» النيات، فالأمير تركي الفيصل من الشخصيات السعودية الديبلوماسية ـ الأمنية الأكثر انخراطاً على الساحتين الإقليمية والدولية، خاصة في المرحلة التي خلف فيها الأمير بندر بن سلطان كسفير للسعودية في واشنطن، وبالتالي فإن الخلفية «الثقيلة» للرجل، تمنح خطابته نوعاً من التمثيل الحقيقي للرأي «الوازن» القادم من داخل أروقة حكام المملكة، بينما عُرف الجنرال الإسرائيلي ياكوف أميدرور، بمعارضته الشديدة للاتفاق النووي الإيراني والانسحاب الإسرائيلي من غزة (فك الارتباط 2005)، وهذا يعني أن الحوار الحتمي «المغلق»، المصاحب للآخر العلني الأكثر «ديبلوماسية»، يتخطى بكثير نزعة «محبين» للسلام، في اللقاء والتقاط الصور التذكارية، الى مستويات تتضمن نقاشات جديّة، حول سلة المتاح من خيارات، في مقابل «التحديات» و «المصالح» التي باتت الرياض تراها مشتركة الى جانب «تل أبيب».
لا يمكن للود السعودي الرسمي مقابل إسرائيل، أن يكون نزعة طبيعية ضمن سياق واقعي، متصل بنظام الحكم أو بتفسيره التاريخي لأحداث المنطقة، فالمملكة برغم خلافها مع نظام و «مشروع» الزعيم المصري الراحل جمال عبدالناصر، ومن بعده الخلاف مع الأنظمة البعثية في سوريا والعراق، وما بينهما من خلاف مع إيران، إلا أنها شاركت، وربما أكثر من غيرها في دول ما بعد «الطوق»، في حروب العرب مع إسرائيل، وبمستويات متفاوتة. لكن الواضح أن التوجه اليوم بات يتخطى «مركزية» الخطر الإسرائيلي، وكذلك «مركزية» القضية الفلسطينية، في قولبة منظومات الأمن القومي التابعة للأقطار العربية الرئيسيّة، بما في ذلك من إعادة صياغة التحالفات، وإعادة عملية إنتاج التعريفات ما بين «عدو» و «صديق» إلى خطّها الأول.
«ترحل» أميركا، ومعها سلّة جديدة من الخيارات والتعريفات والأعداء والأصدقاء، وتبقى السعودية، وهكذا ترى الأخيرة أن الوقت قد حان لامتلاك «سلّة» خاصة بها، تضـــمن ما أمكن، من أسس صناعة السياسات السعودية، أي بــــقاء العائلة الحاكمة كنخبة تمتلك دورتها «الداخليّة» الخاصــة، وكذلك ضمان مصالح الحلفاء التاريخيين في دول مجلس التعاون، بالتوازي مع ضمان الأمن الاقتصادي الخاص بالمجموعة الخليجية. كما يفرض «الانغماس» غير المسبوق للرياض، في الساحات الإقليمية الحامية كسوريا واليمن وليبيا والعراق، وساحات أقل حماوة كمصر، مقاربة جديدة تقوم على تأمين «أصدقاء» وازنين يمكن لجمعهم في «كتلة» استراتيجية واحدة، أن يؤمن فاقد الوزن الأميركي، وكذلك الفاقد من أوزان صديقة سابقة، كالثقل المصري في زمن الرئيس الأسبق حسني مبارك، وفي ظل المعطيات هذه، التي جعلتها الرياض «واقعاً» مـــلازماً لـ «بقائها» ومسار هذا البقاء في المنطقة، جاء الود الأمـــيري للإســـرائيليين متمماً لود آخر، تلاقت من خلاله السعودية مع «إخـــوان» تركـــيا، لتمرير مرحـــلة تحول «الاحتواء الإيراني» الى مواجهة مباشرة، بأقل الخسائر الممكنة.
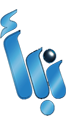 قناة نبأ الفضائية نبأ
قناة نبأ الفضائية نبأ



