* د. فؤاد إبراهيم
ليس سؤال مراهق في السياسة، ولا مجازف في استعجال النتائج؛ فقد طُرح أكثر من مرة في عهد الملك سلمان، ومن قِبَل مقرَّبين من دوائر أجهزة الأمن القومي الأميركي. لم يحسم المشتغلون الجواب، وكان ملء اهتمامهم مندكاً في قرع الأجراس للتحذير من القادم في بلد كان ذات زمن «جزيرة آمنة في محيط مضطرب». على الضد، ثمة جمهرة منافحين عن جدارة الدولة السعودية ورسوخ وجودها، وهم في الغالب من الواقعين تحت تأثير النفوذ المادي لآل سعود، والذين يحاجّون بنصف الكأس الممتلئ. بطبيعة الحال، نحن لا نبحث في ظاهرة الأحصنة التي تصهل جماعياً، فثمة عامل من خارجها يدفع بها إلى فعل ذلك. لا عجب، وكما يقول ميشيل فوكو: «السلطة تحوّل الإنسان إلى دمية سياسية». وفي كل الأحوال، لا يزال هناك من هو أسير لسلطة ينتفع منها على حساب دولة لا تزال عقيمة عن إنتاج وطن لرعاياها.
لم يكن مجازفاً جون حنّا، مستشار الأمن القومي لنائب الرئيس الأميركي الأسبق ديك تشيني، حين طرح السؤال الآتي: هل ستقدم الولايات المتحدة المساعدة إذا بدأت السعودية بالتفكك؟ في مقالة نُشرت في مجلة «فورين بوليسي» في تشرين الأول/ أكتوبر 2015، أي بعد مرور تسعة أشهر على اعتلاء سلمان العرش، نبّه حنّا إدارة أوباما إلى مؤشرات انهيار السعودية، من قبيل تراجع أسعار النفط، أخطاء السياسة الخارجية، وتزايد التوتر مع إيران. وفي الحاصل، من وجهة نظر حنّا، إن تظافر الاقترافات يرقى إلى مستوى التهديد الوجودي للنظام السعودي. في تقديره، ما لم تُدَر الأزمات بنحو صحيح، فإنها قابلة، ختاماً، لأن تُولِّد عاصفة كاملة، وتزيد كثيراً من مخاطر عدم الاستقرار داخل المملكة. المعطيات التي ساقها حنّا يبرز من بينها أيضاً دخول العدوان على اليمن في المجهول، في ظل عجز «التحالف» بقيادة السعودية عن حسم النتائج على الأرض، وهو ما لا يعني فقط نضوب فرص النصر العسكري، بل تآكل النظام نفسه الذي يخسر صدقيته، وتنكشف حدود قوته، بما يجعله يواصل الحرب، وإن بدا العقم سمة راسخة فيها. وهذا يفسر، جزئياً، افتعاله أزمات أخرى جانبية، لإخفاء عيوبه البنيوية.
لنتأمّل المشهد السياسي في عام 2015. كانت العائلة المالكة لا تزال متماسكة في ظل توازن قوى نسبي، وتقاسم سلطة متكافئ بين عدد من البيوتات (سلمان، نايف، عبد الله). يقال الشيء ذاته حول التحالف بين آل سعود والمؤسسة الوهابية بكل فروعها. تحالفٌ أَسَّس لتقاسم سلطة بدأ منذ منتصف القرن الثامن عشر، وهو يُعَدّ أحد منجزات علاقات الهيمنة وفق التفسير «الفوكوي». إذ، على الرغم من اختلال موازين القوى، ولا سيما بعد إعلان المملكة السعودية عام 1932، فإن الحاجة المتبادلة بين الشيخ والأمير أملَتْ نمطاً في العلاقة التدافعية المتبادلة، كل بحسب مآربه. في حقيقة الأمر، حتى ذلك الوقت، لم تنزلق الأخطاء نحو الهاوية والتهديد الكياني. حينذاك أيضاً، لم يكن يوجد خطر من نفاد الأموال في المملكة في أي وقت قريب، ولكن كلما طال أمد العجز في الميزانية، وانخفضت أسعار النفط، وتراجعت احتياطيات النقد الأجنبي، أصبحت الأسواق الدولية أكثر توتراً، فيما لم تكفّ الدولة عن عادة «التقديمات الاجتماعية» لإبقاء قدر «السخط الشعبي» تحت السيطرة وفي أدنى درجاته.
التقط جون حنّا إحصاءات عن الواقع المعيشي في مملكة النفط، من بينها معدل البطالة المرتفع الذي تصل نسبته إلى 30 في المئة، ومعدل الفقر الذي يشمل ربع السكان، ومأساة مكة والموت الجماعي بفعل التدافع (769 حاجاً)، وسقوط الرافعة على الحجاج، ما أدى إلى مقتل مئة حاج، والسؤال التالي عن جدارة آل سعود بإدارة الحرمين، التي أضافت عنصراً جديداً في توتر العلاقات الإيرانية – السعودية. لم يتحلّ جون حنّا بالجرأة في النتائج كما تحلّى بها في إثارة السؤال، وإن لم يستبعد أي شيء، معتبراً أن بقاء الحال على ما هو عليه ضرب من المستحيل، وأن منطق التاريخ يقول إن السعودية تواجه خطراً وجودياً، ولكن هذا الخطر في مراحله المبكرة، إذ لا يزال هناك وقت كافٍ لإدارة الأزمة، من خلال اتخاذ قرارات حكيمة وفي الوقت المناسب.
ابن سلمان يبحث اليوم عن شرعية بديلة بعد فشله في تقديم المنجز
مرّ سؤال جون حنّا ولم يُحدث في حينه دوياً لافتاً، ولكن أعيد طرحه مجدداً في 15 أيار/ مايو 2017، بلغة تبدو جازمة ومتينة ومدجّجة بحقائق جديدة. في سلسلة أعمال «مركز العمل الوقائي» المدعوم من «صندوق روكفلر»، نشر مجلس العلاقات الخارجية (المقرب من المجمع الصناعي العسكري في الولايات المتحدة) مقالة بعنوان: «ما مدى استقرار المملكة السعودية؟». استُهلّت المقالة بتبديد أي انطباع استباقي حول هدفها بالقول إن استقرار السعودية ليست تحت تهديد مباشر، ولكن أسئلة مصير المملكة ستتواصل على مدى طويل. نفي الانهيار الوشيك لم يَحُل دون مقاربته بموجب المعطيات الضالعة في حصوله، أي زعزعة قواعد النظام إما من أسفل من طريق الثورة الشعبية، أو من أعلى من خلال صراع الأجنحة داخل العائلة المالكة، وما بينهما من سيناريوات أخرى: تمرّد عسكري واسع النطاق، أو تدخّل خارجي… أو تآزر مجموعة عوامل تفضي إلى تقويض أركان الدولة. في تقويم «عوامل الخطر»، من قبيل مصادر التوتر الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وقدرة الدولة على إدارة التحديات الداخلية والنزاعات الخارجية، إلى جانب عمق ولاء قوى الأمن الداخلي، وتماسك القيادة، ووحدة الصف الداخلي، يخلص المقال إلى أن مستوى الخطر في السعودية تزايد، ولكن لم يصل إلى مرحلة الخطر.
في مؤشر الدول الهشّة لعام 2017، بحسب تقدير «صندوق السلام»، وهو منظمة غير حكومية أميركية، صُنِّفت المملكة السعودية في المرتبة 101 من بين 178 دولة. مؤشر البنك الدولي للاستقرار السياسي وغياب العنف، وهو واحد من ستة مؤشرات يتبعها في مئتي دولة في مشروع مؤشرات الحكم العالمي، حصلت السعودية على نسبة ثمانية وعشرين في المئة في عام 2015. وفي الفترة ما بين 1996 ـ 2015، كان متوسط درجة المملكة السعودية عند 0.31، مع تصنيف 2.5 ضعيفاً و2.5 درجة قوية. أما تقرير «دول الهشاشة» الصادر عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لعام 2016، فقد ذكر أن السعودية تقع في «نطاق الاستقرار السياسي المعتدل». لم تبدّد تلك المؤشرات القلق، بل يومئ باطنها إلى نذير شؤوم على مستقبل المملكة. ثمة أمثلة وافرة من الدول التي بدت مستقرة ظاهرياً، ولكنها انهارت سريعاً. هكذا كان حال تونس، ومصر، وليبيا، وسوريا.
قد لا تندلع ثورة شعبية في المملكة السعودية في المدى المنظور، دون استبعاد انتفاضات مناطقية أو حتى حالات تمرد قبلية مسلحة في أي وقت. وقد لا يقع انقلاب عسكري من داخل أي من الأذرع العسكرية (الدفاع، الحرس الوطني، قوى الأمن الداخلي… إلخ)، بعدما نجحت العائلة المالكة في اختراقها واستبعاد العناصر المرشّحة لقيادة حركة عصيان مسلح. لكنْ ثمة أشكال من التمرد ليست مستبعدة في ظل التشظّي الحاصل في السلطة وتوزع الولاءات. لا بد من الإشارة إلى أن توحيد مركز القيادة للأذرع العسكرية، بقدر ما يخفّف من احتمالات النزاع المسلح على السلطة بين الأمراء، فإن السخط المتعاظم في أوساط عناصر الدفاع والحرس الوطني والداخلية، بفعل النفوذ المتزايد لمحمد بن سلمان، يغذّي فرص التمرد والانشقاق المدعوم من أمراء فقدوا مناصبهم ونفوذهم، وهذا في حدّ ذاته أحد مغذيات أزمة الخلافة في المستقبل، والذي قد يتطور إلى نزاع مسلح على نطاق واسع.
التغييرات التي أحدثها الملك سلمان منذ توليه العرش حتى الآن هي من نوع الرهانات الوجودية، أي المرتبطة بالمستقبل السياسي لنجله، ومن شأنها أن تبقي التوتر والقلق في ذروته. ويمكن إجمال تلك التغييرات على النحو الآتي: حرب اليمن في 26 آذار/ مارس 2015، إعفاء الأمير مقرن بن عبد العزيز من ولاية العهد في 29 نيسان/ أبريل 2015، إعلان رؤية السعودية 2030 في 25 نيسان/ أبريل 2016، إعفاء الأمير محمد بن نايف من كل مناصبه في 21 حزيران/ يونيو 2017، حملة مكافحة الفساد في 4 تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، التي شملت إعفاء الأمير متعب بن عبد الله من وزارة الحرس الوطني، واعتقاله بتهمة الفساد، ومعه إخوته وأمراء آخرون مثل الوليد بن طلال، ووزراء مثل عادل الفقيه، وتجار كبار مثل صالح كامل ومحمد العمودي.
في الرهان الاقتصادي، أعلن محمد بن سلمان، بصفته رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، عن رؤية السعودية 2030 في 25 نيسان/ أبريل 2016، بهدف تنويع مصادر الدخل، والتحرر من الاعتماد على النفط، وتطوير قطاعات الاقتصاد: الدفاع، تجارة التجزئة، والطاقة المتجددة، والقطاع الخاص. وأُنشئ صندوق الثروة السيادية لدعم الاستثمارات الوطنية. منسوب التفاؤل في خطة «التحول الوطني» كان مرتفعاً للغاية، إلى حدّ أنه وعد بخلق ستة ملايين وظيفة جديدة بحلول عام 2030، وهو رقم يتجاوز بكثير أي شيء أُنجِز في السابق، ولا يأخذ بالاعتبار النساء المحتمل دخولهن سوق العمل. في هذا السياق، تزايد الرهان على دور القطاع الخاص في امتصاص العدد الأكبر من المواطنين بدلاً من الأجانب، فيما كان على الأسر السعودية التكيّف مع فقدان الإعانات السخية، وتقلّص الامتيازات المقدمة لموظفي الحكومة، الذين يشكلون ثلثي إجمالي قوة العمل.
وعلى طريقة جون حنّا، نبّه «مركز العمل الوقائي» هو الآخر، إلى احتمالية التقلب في الوضع الداخلي؛ إذ في حال تجمُّع عوامل عدة، فهي يمكن أن تشكل «عاصفة كاملة»، وقد تؤدي إلى تزايد الاضطرابات وتحديات مفتوحة للأسرة المالكة. في النتائج، يتوقف نجاح مثل هذه التحديات على تماسك النخبة الحاكمة. وبحسب فريق عمل «عدم الاستقرار السياسي» (Political Instability Task Force) المدعوم من قبل وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية لإجراء تقييم لحكومة الولايات المتحدة، يُعدّ هذا العامل (أي تماسك العائلة المالكة) أهم مُحدِّد لما إذا كانت الأنظمة الحاكمة تخضع للتحديات السياسية الداخلية.
من وجهة نظر بروس ريدل، المسؤول السابق في الـ«سي آي إيه» على مدى ثلاثة عقود والمستشار السابق لأربعة رؤساء أميركيين، ثمة انقسام عميق داخل العائلة المالكة بفعل تدابير احتكار السلطة التي اعتمدها محمد بن سلمان بعزل بقية الأمراء النافذين. وعلى رغم احتمائه بجلباب أبيه، إلا أن باب الاحتمالات لا يزال مُشرَّعاً، بما في ذلك الاغتيال. يلفت أيضاً، بناءً على مصادره الخاصة، إلى أن حالة تململ تسود أوساط وزارة الداخلية منذ إعفاء محمد بن نايف، والحال نفسه ينسحب حكماً على الحرس الوطني الذي يدين بالولاء لبيت عبد الله منذ نحو ستين عاماً.
في رهان مماثل، يُعدّ فشل خطة «التحول الوطني» أكبر خطر على المملكة السعودية. رؤية السعودية 2030، كما أسلفنا، هي من نوع الرهانات الوجودية التي تؤول بالبلاد إلى إحدى خاتمتين: المعجزة أو الكارثة. اشتملت «الرؤية» على تحديات جمّة من بينها السعودة، حيث وعدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتوفير 450 ألف فرصة عمل بحلول عام 2020، ومليونَي وظيفة بحلول عام 2030. بحسب أرقام الهيئة العامة للإحصاء، التابعة للحكومة السعودية، هناك 13.3 مليون عامل في السعودية، من بينهم 10.2 ملايين عامل أجنبي، ويمثّلون 76 في المئة. لمعرفة الفارق الفلكي بين الواقعي والمزعوم في خصوص السعودة، يدخل سوقَ العمل المحلية كل عام ربعُ مليون مواطن، فيما دخل سوق العمل 12 ألف مواطن فقط في الفترة ما بين الربع الأول من عام 2017 والربع الأول من عام 2018، ما يجعل دعوى خفض البطالة إلى 9 في المئة بحلول 2020، و7 في المئة بحلول 2030، مجرد وهم. وكان الكاتب والأديب، سعد السريحي، قد حذر من تحول البطالة إلى كارثة، وقال إن «مواجهة البطالة تحتاج إلى معجزة لا يفي بتحقيقها ما يتم إعلانه من فرص وظيفية لا تتجاوز العشرات والمئات في كثير من الدوائر والمؤسسات…».
مشكلة وليّ العهد تكمن في أنه يريد تغيير كل شيء دفعة واحدة
تجدر الإشارة إلى أن العشرات من الشركات المتوسطة الحجم قد توقفت عن العمل منذ بدء تطبيق سياسة السعودة، بالتزامن مع السياسة الضريبية السارية منذ مطلع العام الحالي. وبحسب أحد رجال الأعمال السعوديين، إن إنشاء شركة يتطلب دفع رسوم مالية مُقدّماً لأكثر من خمس عشرة جهة. وفي لقاء وزير العمل مع رؤساء غرف التجارة في المملكة السعودية في شباط/ فبراير الماضي، حذر هؤلاء من السير في خطة السعودة بطريقة عشوائية. ولفت رئيس غرفة تجارة وصناعة الأحساء، عبد اللطيف العرفج، إلى أنهم ليسوا ضد السعودة، «لكن لديهم بعض التحفظات من الآلية التي تبنتها الوزارة»، وهذه الآليات «سيكون لها تأثير سلبي على القطاع الخاص وتسبب إغلاق العديد من الشركات».
بالمثل، شكّل جذب الاستثمارات الأجنبية تحدياً جدياً، ليس للاقتصاد السعودي فحسب، بل ولجدارة محمد بن سلمان في إدارة شؤون الدولة، لكونه يمثل اختبار ثقة من خارج الحدود، حيث الجهات الأكثر حساسية وقدرة على تقدير ما إذا كانت المملكة السعودية «مسرح عمليات تجارية» مناسباً لها. كان الإعلام السعودي يروّج، في الربع الأول من 2018، لدعوى تصاعد الاستثمارات الأجنبية في المملكة، فيما كان ابن سلمان يغدق الأموال على شركات علاقات عامة في الولايات المتحدة للغرض نفسه. ولكن في حزيران/ يونيو الماضي، وضع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية حداً نهائياً لتلك التقديرات المبرمجة، وأفاد بانكماش تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 1.4 مليار دولار في 2017، من 7.5 مليارات دولار في 2016. وكان الهدف المرسوم للاستثمارات الأجنبية يتمثّل في جذب 18.7 مليار دولار بحلول عام 2020، كجزء من إجراءات معالجة مشكلة البطالة.
في تدبير وقائي لدرء خطر الانهيار الشامل الناجم عن الانتقال من إصلاحات جزئية إلى نظم ديمقراطية، لجأ ابن سلمان إلى «نموذج دبي» طلباً للسلامة، بإطلاق حريات اجتماعية منضبطة، بالتزامن مع تضييق شديد على الحريات السياسية. يبقى أن مشكلة ابن سلمان تكمن في أنه يريد تغيير كل شيء دفعة واحدة، وهذا ما يستحضر كل عوامل الخطر من انهيار السعودية دفعة واحدة أيضاً، بحسب رؤية جون حنّا، و«مركز العمل الوقائي». ليس أصدق من المثقفين تعبيراً عن سخطهم ورضاهم، ولهم في ذلك وسائل خاصة وإبداعية أحياناً في التعبير. في زمن الحرية، «كل الناس فلاسفة» كما يقول غرامشي. وليكونوا كذلك، ويقرروا الدولة التي يشاؤون، دولة تشبههم، تحمل سماتهم الثقافية، وخصائصهم الروحية. ولكن في زمن القمع، وحده المثقف الذي عليه أن يقرر الموقف الذي يختار.
لم تشهد نخبة المثقفين في المملكة السعودية أزمة هوية وخطاب وجماعة اجتماعية (strata) كما تشهد اليوم. فالتشظي الذي يعاني منه المثقفون، لا يقتصر على تبعثرهم الكياني، بل أيضاً تقويض وظيفتهم، بجمود حركة التراكم النقدي الذي اعتادوه على مدى عقود، واجتراحهم طرقاً متنوعة في التعبير عن ذاتهم المثقفة. في الظاهر، يبدو هامش مناورة المثقف أمام واقع غير مسبوق قد تقلّص إلى قدر ترجيح السلامة بالانسحاب من هذا الواقع بدلاً من الانغماس فيه، وهذا في حدّ ذاته مؤشر على انفضاض صامت عن السلطة من قِبَل الفئة الاجتماعية الفاعلة. ليس المثقف وحده من اختار الانسحاب الهادىء؛ إذ تكفي مقارنة بسيطة بين جمهور المغرّدين في الأعوام 2011 ـ 2014، والجمهور الجديد في الأعوام 2016 ـ 2018، لاكتشاف ليس فقط تناقض أجندتين فحسب، بل الفارق في سمات جمهورين: تقدمي، تاريخي، عصري؛ في مقابل رجعي، طفولي، حجري.
ما يتعمّد محمد بن سلمان فعله من خلال حملات الاعتقال المتواصلة، وتجميع كل ذيول السلطة بيده، إعادة إنتاج النمط الاحتكاري التقليدي للسلطة عبر عادة التعذيب وتدمير الجسد لترهيب الرعية. فما يهمه ليس مجرد الطاعة المستندة إلى الهيبة، بل الرهبة المولِّدة للخنوع والإذعان. فابن سلمان، حين أخفق في تقديم المنجز (الاقتصادي والعسكري بدرجة أساسية) كمصدر لمشروعيته وضمانة لإجماع الداخل عليه، يبحث اليوم عن شرعية بديلة، نمطية، من خلال العنف واعتقال المعارضين والناشطين وممارسة التعذيب، بما يخوّله إدامة السلطة والهيمنة. كان فوكو صائباً في تفكيك السلطة السياسية وجنوحها نحو العنف والسجن والتعذيب، حين لا تجد سبيلاً سوى ذلك لإنقاذ نفسها. يبقى القول إن الفارق بين الهيبة والرهبة، في معادلة السلطة، تماماً كالفارق بين الطوعي والقهري، ولا يمكن التعويل على سلطة تعتصم بوسائل إكراهية لضمان وجودها واستمرارها.
لن نغامر بالدخول في لعبة الوقت، مع عدم استبعاد أي شيء وفي أي وقت. نعم، ومن حيث المبدأ، ليس هناك سبب مقنع للقول إن السعودية ستنهار وشيكاً. ولكن بناءً على العوامل المرصودة في عدم استقرار النظم السياسية، وهشاشة الدول، ثمة عوامل تتضافر تدريجاً، وهي مرشّحة لأن تجتمع في رياح عاتية تضرب أركان الدولة. قد يكون أسرعها خاتمة، وأهونها، هو الاغتيال، وفق سيناريو الملك فيصل في 1975، وهذا ما ذهبت إليه صحيفة «إيكونوميست» البريطانية في 21 حزيران/ يونيو الماضي، كخاتمة درامية لمقامرة ابن سلمان، فيما اختار بروس ريدل سيناريو توظيف فيصل لتورط سعود في حرب اليمن عام 1962 في الصراع على السلطة، وتالياً عزل سعود ونفيه للخارج، وهو سيناريو قد يتكرر في ظل غرق ابن سلمان في حرب اليمن. ليس أمام النظام السعودي، في ضوء مخاطر الانهيار، ملجأ إلا عبر الهروب إلى الأمام، إلى حرب إقليمية تعيد خلط الأوراق، وتحقق اصطفافاً داخلياً، على الأقل في المنطقة الحاضنة للنظام، وتستدرج تدخلاً خارجياً لإنقاذ مصالحه.
*الدكتور فؤاد إبراهيم، كاتب وباحث سياسي
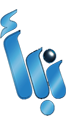 قناة نبأ الفضائية نبأ
قناة نبأ الفضائية نبأ



