السعودية/ نبأ- قال الكاتب اللبناني وسام متى، في تقرير لصحيفة "السفير"، أن تنفيذ حكم الإعدام بحق الشيخ نمر النمر أعاد تسليط الضوء على قضية قديمة من عمر الدولة السعودية الأولى، والمتعلقة بالأوضاع في المنطقة الشرقية، التي ارتبطت بأوضاع مكوّن أساسي في المجتمع السعودي، وهو الأقلية الشيعية.
وأضاف الكاتب، انه لا يوجد إحصاء دقيق لعدد الشيعة السعوديين، فالأجهزة الرسمية تقدرهم بنحو 10 في المئة من إجمالي سكان السعودية، اي 1.75 مليون شخص، يعيش ثلثاهم في المنطقة الشرقية ويتوزعون بين المحافظات الأربع الرئيسية: القطيف والأحساء والدمام والخبر، في حين تشير تقارير أخرى إلى أن هذه النسبة تتراوح ما بين 15 إلى 20 في المئة.
وتعد المنطقة الشرقية أكبر خزان طبيعي للنفط في العالم، ففيها نحو 22 في المئة من احتياطي البترول العالمي الثابت، وتنتج 98 في المئة من نفط المملكة. كما توفر 12 في المئة من إجمالي واردات النفط الأميركية، وحوالي ثلث واردات اليابان. ومع ضم الإنتاج الصناعي في المنطقة الشرقية فإنّ نسبة مساهمتها في الاقتصاد السعودي تصل الى ما يقارب 90 في المئة من الدخل الخارجي.
وبرغم ذلك، فإن معظم أبناء المنطقة الشرقية، البالغ عددهم نحو 4.1 ملايين نسمة، يعانون من إرهاصات علاقة تاريخية مضطربة مع آل سعود، وأكثر اضطراباً مع المؤسسة المتشددة التي يتكئ عليها النظام الملكي الحالي، وتقلبات العواصف الإقليمية والدولية التي دفعوا ثمنها غالياً، رغماً عنهم.
في الحديث عن المنطقة الشرقية لا يمكن تجاوز المكوّن الطائفي فيها، والمتمثل بأبناء الطائفة الشيعية في مملكة آل سعود.
وتتفاوت الآراء بين المؤرخين حول حقبات وظروف انتشار الشيعة في شرق السعودية، ولكن الثابت تاريخياً أن العلاقة بين آل سعود وأهالي المنطقة الشرقية اتسمت بالعداء الشديد منذ الدولة السعودية الأولى.
واستناداً إلى ما يقوله المؤرخون ـ المحلّيون والمستشرقون ـ فإنّ العلاقة بين المجتمع القطيفي والأحسائي والبيئات الأخرى في شبه الجزيرة العربية كانت ترتكز على البعد القبلي/المناطقي، أكثر منه الديني المذهبي.
وتعود أصول أهالي القطيف والأحساء (اللتين كانتا تشكلان ما عُرف قديماً بالبحرين) إلى قبائل ربيعة التي استوطنت الواحات، وبني تميم التي استوطنت البادية. هاتان القبيلتان دخلتا الإسلام بعد الرسالة النبوية.
وفي وقت لاحق، هاجرت قبائل عدّة من شمال الجزيرة العربية وغربها الى المنطقة الشرقية. وقد اعتنق معظم أبناء القبائل المهاجرة المذهب الشيعي، حتى صارت القبيلة الواحدة موزعة بين سنّة وشيعة في مناطق مختلفة.
ومن ناحية أخرى، فإن التواصل الديموغرافي بين أهل القطيف والأحساء والبيئات المجاورة اقتصر على العلاقات بين أبناء القبائل العربية، إن في نجد ووسط شبه الجزيرة العربية، أو مع المجتمعات المدنية في العراق. وخلافاً للمجتمعات الخليجية الأخرى، كالكويت والبحرين والإمارات وقطر، فإن المجتمع القطيفي والأحسائي لم يشهد استيطاناً من قبل عناصر فارسية، برغم التواصل الاقتصادي والجغرافي والديني مع بلاد فارس.
كل ذلك يؤكد، كما يقول كثيرون من الشخصيات الثقافية والسياسية في المنطقة الشرقية، أن هوية المجتمع القطيفي والأحسائي تاريخياً كانت عربية اكثر منها مذهبية، وأن هذا الواقع ما زال قائماً حتى اليوم، برغم التحوّلات التي طرأت خلال العقود الأربعة الأخيرة، مع بروز الشيعية السياسية غداة انتصار «الثورة الإسلامية» في إيران.
وبرغم العلاقات التاريخية المستقرة عبر التاريخ بين أهالي المنطقة الشرقية ومحيطهم العربي من جهة، وبين المكوّنين الشيعي والسني في مختلف أنحاء شبه الجزيرة العربية، إلا أن عوامل عدّة أسهمت في تأزم الوضع في مراحل لاحقة، ولا سيما بعد بروز الدعوة الوهابية التي انطلقت دينية، واتخذت منحى سياسياً بعد تحالف الدرعية الشهير بين محمد بن عبد الوهّاب ومحمد بن سعود (1745).
وتتفق المراجع التاريخية على أن موقف أهل الأحساء تجاه الدعوة الوهابية كان معارضاً، بالنظر الى التطبيق المتشدد للشريعة الإسلامية الذي حاول أتباع محمد بن عبد الوهاب فرضه على البيئة الشرقية، علاوة على أن سياسة التوسع التي انتهجها الثنائي السعودي – الوهابي أثار مخاوف الحكام المحليين على نفوذهم.
ولعلّ بدايات التوتر بين أهالي المنطقة الشرقية والوهابيين تعود الى بدايات تلك الحركة السنية المتشددة في منطقة العيينة، وبالتحديد منذ هدم أتباع بن عبد الوهّاب ضريح زيد بن الخطاب في واحة الجبيلة، ومن ثم رجمهم امرأة اقترفت إثماً. وبحسب المؤرخ الروسي الكسي فاسيلييف، فإن نبأ هذه الجريمة بلغ أسماع حاكم الأحساء والقطيف سليمان بن محمد بن غرير الحميدي، الذي كانت العيينة تعتمد عليه بقدر ما، سواء في تجارتها أو في امتلاك حاكمها عثمان بن حمد بن معمر. ووفقاً لفاسيلييف فإنّ الحميدي أمر بن معمر بقتل بن عبد الوهاب، لكن حاكم العيينة لم يتجرأ ـ أو ربما لم يرغب ـ في ذلك، فنفاه الى الدرعية.
كانت تلك الحادثة بداية لمرحلة طويلة من الصراع بين الزعامات المحلية في الأحساء والقطيف وبين آل سعود، اتخذت شكل غزوات وغزوات مضادة خلال حقبتي الدولة السعودية الأولى (1744 ـ 1818) والثانية (1818-1891).
وتتفاوت وجهات النظر في شرح أسباب العداء بين أهالي القطيف والأحساء وبين الدولة السعودية، بين قائل إن الشيعة استُهدفوا واضطُهدوا بسبب مذهبهم من قبل الوهابيين المتشددين، وبين قائل إن ما أصابهم من حكم آل سعود أصاب أهالي المناطق الأخرى كافة، بما في ذلك السنّية، التي أخضعت للدولتين السعودية الأولى والثانية.
وبصرف النظر عن الخلفية المذهبية والقبلية للعلاقة بين اهالي المنطقة الشرقية والدولة السعودية الأولى والثانية، فإنّ الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية خلال الدولة الحديثة، التي أسسها الملك عبدالعزيز في العام 1902، وما رافقها من أحداث في الداخل والخارج، شكلت الأساس التي تراكمت فوقه كل العوامل التي أفضت الى تحوّل المنطقة الشرقية الى صداع في رأس آل سعود، والتي تتفاوت التوصيفات بشأنها بين من يرى فيها «مسألة شيعية» بحتة، وبين من ينظر إليها باعتبارها رأس جبل الجليد بين الدولة المركزية ومكوّنات المجتمع السعودي.
وخلال مرحلة التأسيس أولى الملك عبد العزيز المنطقة الشرقية أهمية خاصة لأسباب اقتصادية وسياسية.
وعلى المستوى الاقتصادي، فقد عُرفت المنطقة الشرقية تاريخياً، وقبل اكتشاف النفط، بنشاط كبير في قطاعات الزراعة والصيد والحرف، ولذلك فقد نظر إليها الملك المؤسس على أنها رافد مهم لخزينة دولته الناشئة.
أما على المستوى السياسي، فإنّ سعي الملك عبد العزيز الى تطبيع العلاقات مع الحكام المحليين في القطيف والأحساء انطلق من هاجسين، الأول تجنب تكرار أخطاء أسلافه في التعامل مع القبائل الشرقية المتمردة، والثانية قطع الطريق أمام أي توافق عثماني ـ بريطاني على اقتسام الجزيرة العربية.
لم يدم الوفاق بين الدولة السعودية وأهالي المنطقة الشرقية طويلاً. السبب الرئيسي في ذلك كان اشتداد عود «الإخوان» ـ ليس المقصود هنا جماعة «الإخوان المسلمين» التي أسسها حسن البنا في مصر، وإنما مجموعة سعودية سلفية كانت جزءاً من الحركة الوهابية ـ ومحاولتهم فرض رؤيتهم الدينية المتزمتة على الحاكم السياسي.
بدأ التوتر في العام 1927، حين ضغط «الإخوان» على الملك عبد العزيز لتنفيذ فتوى بإجبار الشيعة على الدخول في «دين أهل السنة والجماعة»، عبر منعهم من إظهار شعائرهم، بما في ذلك دعاء أهل البيت، وتعيين أئمة ومؤذنين ونواب سنّة لديهم، ومنع الشيعة العراقيين من دخول الأراضي السعودية.
وبرغم الصدام العنيف الذي وقع بين الدولة السعودية و»الإخوان» في العام 1929، لا سيما بعدما كفّر هؤلاء الملك عبد العزيز، فإن القمع بحق الشيعة استمر، وترافق مع إجراءات اقتصادية، أدت في نهاية المطاف إلى انفجار شعبي، اتخذ شكل عصيان مسلح في العوامية، سرعان ما تم احتواؤه من خلال وساطات محلية.
في تاريخ التاسع والعشرين من أيار لعام 1933 صدر مرسوم ملكي بمنح شركة «ستاندرد أويل أوف كاليفورنيا» الأميركية امتياز التنقيب عن النفط في المنطقة الشرقية (تغيّر اسمها في العام 1944 لتصبح «شركة النفط العربية الأميركية» ـ «ارامكو»).
كانت هذه نقطة فارقة في تاريخ المنطقة الشرقية، افرزت جملة تحوّلات في البنية الاقتصادية ـ الاجتماعية، وامتدت لتطال النواحي الديموغرافية والسياسية.
على المستوى الاقتصادي ـ الاجتماعي، أسهم امتياز «ارامكو» في تحوّل المنطقة الشرقية من طابع الاقتصاد الريفي القائم على الزراعة والصيد والصناعات الحرفية البسيطة، إلى اقتصاد صناعي بامتياز.
وعلى المستوى الديموغرافي، أسهم هذا التحوّل الاقتصادي في جذب أعداد كبيرة من سكان المناطق المتفرقة في المملكة الصاعدة، بعدما اصبحت المنطقة الشرقية وجهتهم الرئيسة للعمل.
أما على المستوى السياسي، فإن هذا التحوّل الاقتصادي – الاجتماعي أسهم في بروز حركات ذات طابع نقابي، سرعان ما راحت ترفع مطالب سياسية إصلاحية تجاوزت البعدين المناطقي والمذهبي.
وعلى هذا الأساس، شهدت سنوات الأربعينيات حراكاً عمالياً، على خلفية التمييز بين العمال الاجانب والمحليين. بعد عقد من الزمن، أفضى هذا الحراك إلى تشكيل أول لجنة نقابية منتخبة في «أرامكو» (1953) مثلت زهاء 22 ألف عامل، وكانت النواة لتشكيل أول تنظيم سياسي وطني باسم «جبهة الإصلاح الوطني» (1954)، التي رفعت مطالب سياسية جريئة أبرزها: وضع دستور للبلاد، انتخاب مجلس للنواب، إنهاء الحكم الملكي المطلق، وتشريع العمل النقابي.
وبعد أربعة أعوام، وفي ظل تصاعد حركة التحرر الوطني، وتعاظم دور الحركة الشيوعية في العالم، اعتمد التشكيل السياسي اسم «حركة التحرير الوطني»، كتنظيم ماركسي، فيما تشكلت العديد من الحركات ذات الطابع الليبرالي والقومي الناصري التي كان لأهل المنطقة الشرقية حصة كبيرة ضمن هيئاتها القيادية وكادراتها الوسطية وقواعدها.
لكن العصر الذهبي للحركة الوطنية السعودية لم يدم طويلاً، ففي العام 1969، وعلى خلفية محاولة انقلاب عسكري فاشلة، تم اعتقال مئات القيادات اليسارية والبعثية والناصرية، في ما اعتبر حينها ضربة قاصمة. وفي مرحلة التحوّلات/الانتكاسات الكبرى التي أصابت المشروع القومي التحرري، بعد «نكسة» العام 1967، ورحيل الرئيس جمال عبد الناصر، كان العد العكسي يبدأ لأفول نجم التيارات المدنية لمصلحة الإسلام السياسي.
ولعلّ سنوات الأربعينيات والخمسينيات والستينيات انتجت جيلاً جديداً من أبناء المنطقة الشرقية أقل تأثراً بالموروث المذهبي الشيعي، لا بل إن اتجاهاتهم راحت باتجاه التعبير عن هوية ثقافية ـ اجتماعية ـ سياسية.
ويبدو أن هذا الأمر قد أثار قلق السلطات الحاكمة في السعودية ـ بجناحيها السياسي والديني ـ وهذا ما تُرجم باعتماد سياسة التهميش على المستوى الإداري والسياسي.
في كتابهما «الحراك الشيعي في السعودية ـ تسييس المذهبة ومذهبة السياسة»ـ يشير الباحثان بدر الإبراهيم ومحمد الصادق إلى أنه «عند دراسة مشكلة الأقلية في الدولة الحديثة، نجد أن فعالية الجهاز البيروقراطي للدولة تساعد بلا أدنى شك على احتواء الأقلية من خلال توفير الوظائف لأبنائها، وبالتالي، خلق شعور عام لدى هذه الأقلية بوجود مصلحة مباشرة مرتبطة ببقاء الدولة وقوتها خلال عملية تكوّن العملية الوطنية، ما يسهّل عملية الاندماج، لكن ما حدث مع شيعة السعودية هو العكس، فقد عزز نمو جسد الدولة وتطوره شعور الأقلية بالتمييز الطائفي من خلال حرمان الشيعة من الوصول الى بعض المناصب الإدارية العليا أو دخول بعض القطاعات العسكرية».
هذا التمييز الطائفي، رصده تقرير صادر عن «مجموعة الأزمات الدولية» في أيلول العام 2005، بعنوان «المسألة الشيعية في المملكة العربية السعودية»، وأشارت فيه إلى أنه «من بين أكثر أشكال مظاهر التمييز وضوحاً يمكن الحديث عن التمثيل الشيعي في المناصب العامة. لم يحدث أن تم تعيين وزير أو عضو في الحكومة الملكية، والسفير الشيعي الوحيد كان جميل الجيشي، الذي رأس البعثة الديبلوماسية في إيران بين العامين 1999 و2003. وحين قام الملك فهد في العام 2005 بتوسيع مجلس الشورى من 120 إلى 150 عضواً، كانت الحصة الإضافية للشيعة عضوين، إلى جانب عضوين سابقين. وأما إعادة تشكيل المجالس المحلية الخمسة عشرة، فشهدت انخفاض التمثيل الشيعي في المنطقة الشرقية من عضوين إلى عضو واحد».
وأشار التقرير كذلك الى الخطاب التحريضي ضد الشيعة في المؤسسات التعليمية السنية من قبيل وصفهم بـ «الكفار» و «المشركين» و «الروافض».
هذا التمييز تمتد جذوره الى حقبة طويلة، تحت ضغط المؤسسة الدينية الوهابية في السعودية.
وفي مرحلة تراجع المشروع القومي/اليساري في الشرق الاوسط، لمصلحة ما سُمّي بالصحوة/الردّة الدينية في السبعينيات، والتي كان من نتائجها انتصار «الثورة الإسلامية» في إيران، كان من الطبيعي أن تترك تلك التطورات أثرها على المكوّن الشيعي في المنطقة الشرقية.
على هذا الأساس، برزت مجموعة من الحركات المعبّرة عن الهوية المذهبية في المجتمع القطيفي والأحسائي، تفاوتت أهدافها بين «تصدير الثورة» بحسب الرؤية الخمينية والمطالبة بالإصلاح من بوابة حقوق الطائفة/المذهب.
في هذا الجو، تأسست حركة «الرساليين الطلائع» في العراق في العام 1967، والمعروفة بـ «التيار الشيرازي» (نسبة الى عالم الدين محمد الشيرازي) التي انتقل فكرها وتأثيرها الى شيعة السعودية، وحركة «الثورة الإسلامية في الجزيرة العربية» بقيادة الشيخ حسن الصفار، و «حزب الله ـ الحجاز»، وبروز دور المُعَممين في العمل النضالي، وأشهرهم الشيخ نمر النمر، الذي سطع نجمه بقوة منذ بداية الألفية الثالثة، وبشكل أقوى خلال مرحلة «الربيع العربي» حين تحوّل الى رمز للشباب الشيعي المنتفض ضد الظلم اللاحق بأبناء المنطقة الشرقية.
برغم التمييز الفاضح بحقهم من قبل نظام الحكم السعودي، وموجة التحريض الممنهجة ضدهم من قبل المؤسسة الدينية الوهابية، فإن أبناء المنطقة الشرقية ـ او معظمهم – لم يجنحوا نحو ما يمكن ان يوصف بأنه دعوة الى الانفصال وهدم الدولة. والأمر هنا لا يقتصر على الشخصيات الليبرالية او القومية او اليسارية، بل يشمل شخصيات تعمل تحت راية مذهبية، والدليل على ذلك، استجابة الشيرازيين أنفسهم للمساعي التي بذلها الملك فهد في مطلع التسعينيات لحل المسألة الشيعية في إطار داخلي. وبالفعل فقد اطلقت مبادرة وطنية أفضت إلى عودة المئات من المعارضين من الخارج بعد لقاء مع الملك فهد، الذي تعهد بإنهاء سياسة التمييز الطائفي، وهو ما لم يحدث بسبب الضغوط المضادة التي مارستها جهات في الأسرة المالكة (وتحديداً الأمير نايف بن عبد العزيز).
وليس أقل دلالة كذلك على التوجهات الوطنية لأهالي المنطقة الشرقية وثيقتا «شركاء في الوطن» و«رؤيا الحاضر ومستقبل الوطن» اللتين قدمتهما شخصيات شيعية لولي العهد حينها عبد الله بن عبد العزيز في ربيع العام 2003، واللتين تضمنتا «مطالب الشيعة من أجل وحدة المملكة والبعد عن خطر التقسيم وتفويت الفرصة على المتربصين من الخارج».
في خضم مرحلة التحولات التي تشهدها المنطقة العربية، وفي ظل ما يحكى في الإعلام الغربي عن مخطط تقسيمي يطال السعودية، وفي ضوء الصعوبات الاقتصادية التي بدأت تواجهها المملكة النفطية، ثمة حاجة إلى التحرّك نحو الأمام عبر خطوات إصلاحية تحل المسألة الشيعية أو مسألة المنطقة الشرقية.
بلغة المنطق فإنّ حل المشاكل يبدأ من الحوار.. ولكن إعدام الشيخ النمر يعكس أن حكام مملكة آل سعود ليسوا في هذه الوجهة!
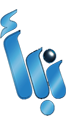 قناة نبأ الفضائية نبأ
قناة نبأ الفضائية نبأ



