السعودية / ديفيد إغناتيوس – واشنطون بوست:
بينما تحترق العراق وسوريا بالنيران، لا يبدو أن المملكة العربية السعودية الغنية بالنفط تحتلّ موقعًا متقدمًا في التفكير الأمريكي. ولكن الرياض سوف تكون حليفًا حاسمًا، بينما تسعى الولايات المتحدة لحشد المسلمين السنة ضد الدولة الإسلامية الإرهابية.
ويقول العديد من نقاد المملكة إنّ السعودية نفسها ساعدت في انتشار الفيروس السام من خلال تمويل المتمردين الإسلاميين، وأيديولوجيتهم السلفية المتطرفة. ولعزْل نفسَها عن مثل هذه الانتقادات، تبرعت المملكة مؤخرًا بـ 100 مليون دولار لمركز مكافحة الإرهاب الجديد للأمم المتحدة، وأعلن زعيم ديني بارز فيها، وهو مفتي الدولة، أن داعش هي سلف تنظيم القاعدة، وهي “العدو رقم واحد للإسلام”.
ومما يزيد في تعقيد الدور المحوري للمملكة العربية السعودية في احتواء عدم الاستقرار في المنطقة هو حقيقة أن التغيير قادم ببطء إلى المملكة. الرهانات بالنسبة للولايات المتحدة في هذه المرحلة الانتقالية من القيادة، هي رهانات كبيرة، ويصعب التنبؤ بنتائجها.
الملك عبد الله يبقى ملكًا شعبيًّا ومحترمًا عمومًا. ولكنه في عامه الـ 90، وقد ظهرت التوترات في العديد من الوزارات السعودية خلال العام الماضي، ممّا يشير إلى وجود مناورات على السلطة. لجيل كامل، كان الأمريكيون والسعوديون يشعرون بالقلق من أن المملكة برميل بارود يحتمل الانفجار في أي لحظة، وذلك مع وجود المتطرفين المسلمين والعلمانيين الذين يتنافسون من أجل تقويض النظام الملكي المحافظ. المملكة تبدو أكثر استقرارًا بقليل الآن مما كانت عليه قبل عقد من الزمن. ولكن المتطرفين السنة والشيعة، ورغم عداوتهم القاتلة لبعضهم البعض، يشتركون بحلم إسقاط آل سعود.
ويصف الخبراء العرب وخبراء الولايات المتحدة المملكة العربية السعودية كمملكة تشعر بالقلق تجاه ثلاثة مخاطر، وهي صعود إيران وحلفائها الشيعة؛ عودة ظهور التطرف السني الذي تجسده الدولة الإسلامية؛ وتراجع الولايات المتحدة كقوة عظمى شكلت الحامي للمملكة.
ويتضح الوضع غير المستقر من خلال النظر إلى الأمير الزئبقي بندر بن سلطان. أُطيح به كرئيس للمخابرات في أبريل الماضي، ثم تمت إعادة تأهيله هذا الصيف مع عنوان شرفي كرئيس لمجلس الأمن القومي. والنتيجة هي ربما ربح صاف للاستقرار السعودي، حيث إن خالد بن بندر بن عبد العزيز، وهو الرئيس الجديد لجهاز المخابرات، يعتبر أكثر موثوقية ومهنية، وهو يعمل بشكل جيد مع الأمير محمد بن نايف، وهو وزير الداخلية الذي تثق به الولايات المتحدة.
وقد سافر رئيس المخابرات الجديد ووزير الداخلية، برفقة وزير الخارجية سعود الفيصل، إلى قطر هذا الأسبوع، مشكلين جبهة موحدة في وجه المنافس الإقليمي، الذي كثيرًا ما أفسد السياسة السعودية الأمريكية.
وكان هناك علامة استفهام حول ولي العهد الأمير سلمان (78 عامًا)، وهو وزير الدفاع، الذي يقال إنه في حالة صحية سيئة. وزاد تعيين الأمير مقرن نائبًا لولي العهد، في مارس الماضي، من التكهنات حول خليفة الملك. وفي الوقت نفسه، عانى سلمان في تسيير أمور وزارة الدفاع. ومنذ توليه هذا المنصب في نوفمبر 2011، كان لديه أربعة نواب، من بينهم اثنان من أبناء سلفه، الأمير سلطان.
والكارت الجريء على سطح السفينة السعودية هو بندر، السفير السابق واللامع لدى واشنطن. عندما كان رئيسًا للاستخبارات السعودية، وممولًا لحلفاء السعودية في سوريا ولبنان، كان يمكن التنبؤ به في عيون واشنطن، كمشغل.
ولكن، يخشى بعض الأمريكيين من أن جهود بندر السرية في الحرب الأهلية السورية وضعت البيض من غير قصد في سلة إرهابيي القاعدة. وشعر المسؤولون الأمريكيون بالارتياح عندما تمت إزالة بندر بوصفه ممثلًا للمعارضة السورية.
ولقد كان كابوسًا متكررًا بالنسبة للسعودية أنها، وفي سبيل محاربة الأعداء الخارجيين، تشجع الحركات السنية المتطرفة، والتي تتحول إلى تهديد للمملكة نفسها فيما بعد.
حدث هذا في الثمانينيات، عندما انضم السعوديون إلى وكالة المخابرات المركزية الأمريكية لرعاية المجاهدين في أفغانستان. طرد المقاتلون المسلمون الأتقياء القوات السوفيتية حينها، ولكنهم تطوروا فيما بعد إلى حركة طالبان والقاعدة.
لا بد أن السعوديين قلقون من أن شيئًا مماثلًا قد حدث مرة أخرى. بعض المقاتلين السنة الذين أيدتهم المملكة ضد إيران، جنحوا الآن تجاه الدولة الإسلامية. السعوديون لم يتعمدوا وقوع هذه الكارثة، ولكن عليهم الآن بالتأكيد التعامل معها.
بالنسبة للمملكة العربية السعودية، تحديات كبيرة تكمن في الأفق القريب.
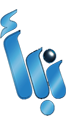 قناة نبأ الفضائية نبأ
قناة نبأ الفضائية نبأ



