* فؤاد إبراهيم
بكل الاعتبارات الجيوسياسية والأمنية والاقتصادية، حوار الرياض وطهران ضرورة مشتركة. لعبة التأجيل التي اعتمدتها السعودية في السنوات الفائتة كانت لأسباب غير منطقية، أكثرها داخلي وقليل منها خارجي. فكانت شيطنة إيران مادة التوجيه الرئيسة للرأي العام المحلي طوال عهد سلمان، كما عكسها الإعلام المحلي وتوابعه خارج الحدود، وكذلك طاقم وزارة الخارجية، بل حتى الملك ونجله ولي العهد. وهذا في حدّ ذاته يفسّر الصعوبة الشديدة لبدء المملكة حواراً علنياً من نقطة الخصومة حين بلوغها سويّة اللاعودة أو قريباً منها. لكن، في المعطيات، ودرءاً لأيّ مفاجآت غير سارة، حرّكت الرياض خطّ وساطات مستقلاً، لشق قناة حوارية سرية مع طهران. كانت بغداد لاعباً فاعلاً في هذا الخط.
الحقن المتواصل لقاعدة النظام السعودي بعداوة إيران، وتصوير الأخيرة على أنها الخصم التاريخي اللدود والوحيد (وليس الكيان الإسرائيلي الذي يرفل هذه الأيام بحفاوة غير مسبوقة وسط أنصار محمد بن سلمان)، بل والتهديد بنقل الحرب إلى داخلها (كما جاء في مقابلة تلفزيونية مع ابن سلمان على شاشة قناة السعودية الرسمية في 2 أيار 2017)، وإشباع الذاكرة الجمعية بصور ذات دلالة عن مواجهة افتراضية كبرى تمحى فيها طهران ومدن أخرى، وتطاح رؤوس كبيرة في الجمهورية الإسلامية، كل ذلك وأضعافه مثّل الإمكانية الراجحة لحرب كراهية شديدة الضراوة، ودمّر بشكل ممنهج فرص اللقاء والحوار بين البلدين.
المسارات بين واشنطن والرياض تفترق
في تآزر مع خط التوتر العالي بين طهران والرياض، كانت «إيرانوفوبيا» بمواصفاتها الأميركية والإسرائيلية المادة اللاصقة لتحالف استراتيجي، جرى تصميمه للتمهيد لحرب محاور فاصلة في المنطقة. محاولات جمّة عمل على إنضاجها سدنة الحروب في الإدارة الأميركية (جون بولتون، ومايك بومبيو، ومايك بنس)، إلى جانب رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، وولي عهد الرياض محمد بن سلمان، وأخذت وسم «ناتو عربي»، و«ناتو إقليمي»… وجميعها يلتقي عند نقطة الحرب على إيران. فشل المحاولات كان بنيوياً أكثر من أي شيء آخر. تموت المبادرات في مهدها، كما حصل في مؤتمر وارسو في شباط من هذا العام، الذي كان مصمّماً لحرب سياسية واقتصادية، ولاحقاً عسكرية ضد إيران. غابت روسيا والصين ودول وازنة في الاتحاد الأوروبي (فرنسا وألمانيا بدرجة أساسية)، وأفرغ الدبلوماسيون السعودي والبحريني ومعهما الإسرائيلي أقصى ما في جعبتهم من خصومة، إلى حدّ أن وزير الخارجية البحريني، خالد بن أحمد، قالها صراحة: «التهديد الإيراني أهم من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي»، متناغماً مع تصريح نظيره الأميركي بومبيو بأنه «لا يمكن تحقيق الاستقرار والسلام في الشرق الأوسط من دون مواجهة إيران».
وعلى قدر منسوب التصعيد في اللهجة العدائية لإيران في مؤتمر وراسو، فإن الفشل بدا حليفاً دائماً لمبادرات واشنطن والرياض وتل أبيب، بما يبطن نتيجة باتت يقينية مفادها أن الأسس التي بني عليها التحالف ليست فحسب غير متينة، بل تبعث إشارات عكسية بأن لا ثقة راسخة بين الأطراف الضالعين في تشكيل التحالف، وأن ثمة أجندات متضاربة تحول دون نجاحه. وهنا، تفترق المسارات بين واشنطن والرياض، فما تريده الأخيرة بات غير متوافر لدى شريكها الاستراتيجي، فلا هو على استعداد لخوص الحرب نيابة عنها، ولا هو قادر على حماية عرشها بتوفير شروط استدامته واستقراره. وتيرة خطابات التوهين للرئيس دونالد ترامب زادت نوعياً في الآونة الأخيرة إلى حد ملامسة أساس التحالف الاستراتيجي بين الدولتين (النفط مقابل الحماية) بحديثه عن تضاؤل حاجة واشنطن إلى نفط الخليج بعد أن أصبحت أكبر منتج للنفط والغاز في العالم. وبالرغم من براعته حدّ الهبل في إنتاج الكذب، فإنه للمرة الأولى يحكي الحقيقة. فبحسب إدارة معلومات الطاقة الأميركية، فإن إنتاج النفط لهذا العام قُدّر بـ 12.3 مليون برميل يومياً، ويتوقع وصوله إلى 13.3 مليون في العام 2020، وهو الأعلى عالمياً، فيما تقدر وكالة الطاقة الدولية بلوغه 17 مليون برميل يومياً في العام 2023.
في النتائج، ثمة متغيّر جيوستراتيجي مفصلي ينعكس تلقائياً على العلاقات التاريخية بين واشنطن والرياض، وهو ما عبّر عنه ترامب بخطابه الشعبوي، بأن بلاده لم تعد بحاجة إلى حماية مشيخات النفط في الخليج، لانتفاء السبب، وعلى الصين واليابان أن تحميا سفنهما، لأنهما المستفيد الأكبر من هذه المنطقة. ولكن ثمة ما هو أبعد من ذلك. صحيح أن ترامب حصد مئات المليارات من الدولارات من السعودية في هيئة صفقات عسكرية وتجارية غير مسبوقة، وأعيد تفعيل عنصر «الشخصنة» في العلاقة بين بيوتات الحكم في واشنطن والرياض، وهو ما يميل إليه الملوك السعوديون، إلا أن ذلك كله لم يحدث أدنى تغيير في قاعدة الثقة المتصدّعة منذ مطلع الألفية، وتحديداً منذ هجمات 11 أيلول، حين وُصفت السعودية بكونها «بؤرة الشر». كان عهد باراك أوباما كابوساً سعودياً، وإسرائيلياً أيضاً، بالرغم من أن كثيراً من الشرور على شعوب المنطقة تُنسب إلى هذا العهد بحق، ومن بينها: التدخل العسكري في البحرين، العدوان على اليمن، التخريب في سوريا، وليبيا، والعراق… وقد حصد أوباما من صفقات الأسلحة السعودية ما لم يحصده رئيس من قبله. نعم هو يختلف قليلاً في مقاربة ملف إيران، وهنا مربط الفرس.
سيناريو الحوار الإيراني الأميركي
الحوار الأميركي الإيراني في سلطنة عمان حول الملف النووي حصراً كان بالنسبة إلى الرياض طعنة في الظهر، وكان بمثابة متغيّر جديد في التفكير السياسي والاستراتيجي السعودي. الزلزلة العنيفة لقاعدة الثقة بين واشنطن والرياض على وقع خسارة رهانات الأخيرة في الحرب على سوريا في أيلول 2013 على خلفية سيناريو الهجوم الكيميائي على الغوطة الشرقية في آب من العام نفسه، مثّل اختباراً شديد القسوة للجانب السعودي. فوز المرشح الجمهوري، دونالد ترامب، بالرئاسة الأميركية في انتخابات 2016 لم يكن رغبة سعودية ابتداءً، ولكنه تحوّل حلماً في مرحلة لاحقة. وضعت الرياض كل ثقلها حتى يحقق ترامب ما عجز عنه أوباما لجهة تغيير قواعد اللعبة مع إيران. ولكن، لم يطل الوقت بالنسبة إلى الرياض كيما تكتشف أن ترامب تاجر أكثر منه سياسياً، وأن خصومته مع إيران ليست مبنية على اقتناعات أيديولوجية أو سياسية. فانسحابه من الاتفاق النووي مع إيران في أيار 2018 لم يقصد به إغلاق باب الحوار، ولا إلغاء فكرة التفاوض معها، بل على العكس، وكما ظهر لاحقاً، كان لاستدراج مفاوضات جديدة تُتوّج باتفاق نووي ممهور بختمه، ويكون صالحاً للتوظيف الانتخابي في خريف العام 2020. السعودية، شأن دول خليجية أخرى، مكلومة على خلفية خديعة الحوار السرّي بين طهران وواشنطن في سلطنة عمان في عهد إدارة أوباما، ويسوؤها الوقوع تحت وطأة خديعة أخرى، وهذا ما لفت إليه، ضمنياً، وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد، في 9 حزيران الماضي، بقوله إن «أي اتفاق مستقبلي مع إيران يجب أن يشمل دول المنطقة، بحيث تكون طرفاً فيه». السعودية التي ترى الطوّافين بعروض ترامب لاستدراج مفاوضات مع طهران يضيرها أن تجد نفسها على هامش اتفاقيات تملى عليها، في وقت تتلقى فيه عبارات الإذلال وكشف الظهر، وأشدّها قساوة قول ترامب عنها إنها عاجزة عن الصمود لأسبوع واحد من دون حماية الولايات المتحدة. اعتادت الرياض العمل وفق حكمة: «الكذبة المكسوّة أفضل من الحقيقة العارية»، وفي لعبة موازين القوى كانت تتصرّف السعودية على خلاف وهنها البنيوي وانكساراتها في ملفات المواجهة مع محور المقاومة من لبنان مروراً بسوريا والعراق وصولاً إلى اليمن.
الضغوط الاقتصادية المتصاعدة على إيران لم تكن محض أميركية، بل تأتي في سياق تحالف دولي تشارك فيه إلى جانب الولايات المتحدة، أوروبا، ودول الخليج، ولا سيما السعودية والإمارات، باستخدام ورقتي النفط والتومان لتقويض الاستقرار الاقتصادي والمالي في إيران. كثافة الضغوط الاقتصادية على إيران هي من دون ريب غير مسبوقة، وقد تركت تأثيراتها على كل شيء، وحتى على المائدة اليومية للإيرانيين، ولكن ما فاجأ الأميركيين وحلفاءهم الأوروبيين والإقليميين هو قدرة إيران على «إدارة الأزمة». وفي نهاية المطاف، هذه الأزمة ليست معزولة عن تجربة حصار طويل الأمد عاشته إيران منذ انتصار ثورتها في العام 1979، فقد نجحت طهران في عزل الآثار السياسية للضغوط الاقتصادية، وهذا الذي دفع ترامب إلى نقل العقوبات المالية إلى الأشخاص بدلاً من المؤسسات، في رسالة واضحة إلى نجاح الفريق الدبلوماسي الإيراني الذي أدار الأزمة. فثمة ما يدعو إلى التندّر في فرض عقوبات مالية على وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، لرفضه لقاء ترامب!
في حوار الرياض ــــ طهران، كانت الأخيرة أكثر وضوحاً وشفافية؛ فالشعب الإيراني لا يخضع تحت موجة تحريض على مدار الساعة ضد السعودية، ولا من أولويات طهران الخصومة حدّ الفجور مع الرياض، وإن شكّلت المنافس الإقليمي لها في أكثر من ملف. بمعنى آخر، تعبّر طهران بكل وضوح عن أن معركتها هي مع «الشيطان الأكبر»، القابع في البيت الأبيض، وأن استنزاف الجهود في معارك جانبية يعني خدمة له. التصريحات المتكرّرة والعلنية للمسؤولين الإيرانيين لإطلاق حوار إقليمي حول أمن الخليج أو على مستوى ثنائي مع السعودية وبقية دول الخليج ليست جديدة، وليست نتيجة متغيّرات في السياسة الأميركية مع وصول ترامب. فالدعوات إلى بناء نظام أمن إقليمي، تشارك فيه دول الخليج كافة، كانت من صميم السياسة الخارجية الإيرانية، مع استبعاد كل القوى الأجنبية، ولا سيما الأميركية. في المقابل، تتمسك السعودية ودول مجلس التعاون عموماً بخيار استبعاد إيران والعراق من أي ترتيبات خاصة بأمن الخليج تضعف دور أميركا خليجياً، ودور «الشقيقة الكبرى» في مجلس التعاون.
الدخان الأبيض يخرج من بغداد
في المعطيات، ودرءاً لأيّ مفاجآت غير سارة، حرّكت الرياض خط وساطات خاصاً بها لشق قناة حوارية سرّية مع طهران. كانت بغداد لاعباً فاعلاً في هذا الخط. عرضُ ظريف من بغداد في 26 أيار الماضي اتفاقية «عدم اعتداء» على دول الخليج لم يكن قفزة في الهواء. كان بداية إطلاق الدخان الأبيض لمبادرة حوارية سعودية ــــ إيرانية عملت بغداد على إنجاحها. وبقدر ما تخشى الرياض من جولة حوارية أميركية ــــ إيرانية خارج نطاق رادارها السياسي، فإنها في الوقت نفسه تبدو مذعورة من أي حوار مع طهران لا تأخذ واشنطن علماً مسبقاً به. وقد همس مسؤول سعودي رفيع ذات مرة في أذن أحد السياسيين المخضرمين العرب بأن ثمة من يوصل أخبارنا إلى واشنطن ولا نريد أن نغضبها.
الوفد العسكري الإماراتي الذي زار طهران في 30 تموز الماضي للاتفاق على ترتيبات أمنية وملاحية في الظاهر، لم يكن عزفاً منفرداً، ومن دون تنسيق مسبق مع واشنطن والرياض. وكذلك الحال بالنسبة إلى التصريحات الهادئة والاستيعابية التي أطلقتها أبو ظبي حيال طهران، وبعضها لأسباب داخلية إماراتية، حيث تعاني الإمارات من أزمة ركود اقتصادي غير مسبوقة. مؤشرات متوالية تفيد بأن ثمة حركة مياه تحت الجسر، فالإمارات ليست وحدها التي تنسج علاقة خلف الكواليس، وأمامها أحياناً، فالسعودية تطلق إشارات حوارية وعروضاً أيضاً. تصريح محمد بن سلمان لصحيفة «الشرق الأوسط» في 16 حزيران الماضي بأن بلاده «لا تريد حرباً في المنطقة» هو، من وجه، رسالة تراجع عن خيار نقل الحرب إلى داخل إيران.
وبعد توصل الرياض وطهران إلى تفاهم في 3 آب الجاري يقضي بفتح مكتب رعاية مصالح إيران في السفارة السويسرية في الرياض، وهو الملف الذي بتّ فيه الطرفان في العام 2016، ثم تمّ الاتفاق في شأنه في تشرين الأول 2017 ولم يدخل حيز التنفيذ، مهّد لزيارة وفد سعودي إلى طهران قبل عيد الأضحى وما بعده. في حقيقة الأمر، كان التنسيق اللافت بين طهران والرياض في شؤون الحج بوابة نموذجية للدخول في مفاوضات أشمل. إشارة أخرى لافتة كشف عنها المندوب السعودي لدى الأمم المتحدة، عبد الله المعلمي، في 18 تموز الماضي، عندما قال إن «هناك اتصالات جرت مع طهران من خلال مؤتمر القمة الإسلامية الذي عقد في مكة المكرمة»، مطلع حزيران الماضي، من دون مزيد من التوضيح. في المعطيات، الاتصالات التي يتحدث عنها المعلمي هي ثمرة وساطة عراقية بطلب سعودي (نقله شخصياً ثامر السبهان)، كان فاتحة لاتصالات لاحقة. واصلت الرياض رسائلها إلى طهران، ومن بينها الإفراج عن ناقلة نفط إيرانية في 20 تموز الماضي بعد احتجازها منذ نيسان الفائت، بعدما اضطرت إلى الرسوّ في ميناء جدة بسبب عطل فني. وكانت الرياض ترفض الإفراج عن السفينة حتى بعد إصلاحها، في سياق الحرب الاقتصادية على إيران.
ماذا تريد السعودية؟
لئن اتفقنا على أن قناة الاتصال بين طهران والرياض باتت تعمل بلا انقطاع، يبقى سؤال: ماذا تريد السعودية من الحوار مع إيران؟ بإمكان المرء أن يعثر بسهولة على مضمون التفكير الرغبوي لدى الكتّاب السعوديين في ما تريده دولتهم من الجانب الإيراني. على سبيل المثال: هم يريدون انسحاباً إيرانياً من لبنان، وسوريا، والعراق، واليمن، وفلسطين، ومن المنطقة عموماً. ويريدون من إيران تغيير خطابها السياسي المناهض لأميركا، والكيان الإسرائيلي، والاعتراف للسعودية بأنها الدولة الرائدة في المنطقة. وفي ضوء ذلك، نفترض في البدء والخاتمة أن السعودية في الموقع الذي يملي، لأنها خرجت منتصرة في كل هذه الساحات. فهل بالفعل هي كذلك؟ قرار القيادة السعودية إبقاء الفجوة بينها وبين الكتّاب الأقرب إلى تفكيرها من دون ردم يحيل جمهور السلطة إلى ما يسميه والتر ليبمان «القطيع الحائر». في كواليس الحوار بين طهران والرياض لا تتم مقاربة الملفات الخلافية على طريقة «أطلب وتمنى»، فثمة موازين قوى حاكمة على الحوار، وهذا ما أدركته الرياض متأخراً، ولو كانت في موقع الذي يملي لأبقت عنادها فيصلاً في حركتها الدبلوماسية.
* كاتب وباحث سياسي سعودي
المقال منشور في صحيفة “الأخبار” اللبنانية، يوم الثلاثاء 20 أغسطس / آب 2019
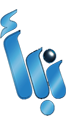 قناة نبأ الفضائية نبأ
قناة نبأ الفضائية نبأ



