اعتبرته قناة «العربية» السعودية كشفاً، في تقريرها من الرياض عن هوية الشاب الذي فجّر نفسه في فندق «دي روي» في منطقة الروشة غرب العاصمة بيروت، وذكرت بالحرف: «إن الشاب سعودي، ويدعى عبد الرحمن ناصر الشنيفي (20 عاماً)، وهو مطلوب من قبل الأمن السعودي وقد غادر أراضي المملكة في العاشر من مارس الماضي» («العربية»، 26 حزيران).
د.فؤاد إبراهيم/ جريدة الأخبار
السؤال: كيف استطاع شخص مطلوب أمنياً مغادرة البلاد عبر المطار متوجّهاً الى اسطنبول في التاريخ المذكور دون أن توقفه سلطات الأمن السعودية؟
الاحتمالات مفتوحة وأهمها:
ـ أن يكون الشخص المطلوب قد غادر البلاد بجواز سفر مزوّر، وهذا ما لم يثبت، وإن ثبت يعد اختراقاً أمنياً خطيراً وقد تميل السلطات السعودية الى هذا الاحتمال في حال وجدت نفسها في موضع الاتهام. ونلفت هنا الى أن استخدام جواز سفر مزوّر في دولة تعتمد شبكة الكترونية دقيقة وجواز سفر معقّد وعصي على التزوير.
ـ أن يكون ثمة تواطؤ بين الامن السعودي والشخص المطلوب ما سمح له بالسفر من دون مروره بإجراءات التدقيق الأمني المعتمدة في منافذ العبور كافة، والتي تشمل في الأحوال الاعتيادية جميع المسافرين من دون استثناء. بمعنى آخر، قد تكون هناك جهة ما قدّمت تسهيلات لسفره ومن معه، وهو احتمال وارد ببساطة لوجود سوابق، منها ما كشفت عنه وثيقة صادرة عن وزارة الداخلية بتاريخ 16 نيسان 2012 حين اتُفق مع متّهمين بتهريب المخدرات والقتل والاغتصاب من جنسيات سعودية ويمنية وفلسطينية وسودانية وسورية وأردنية وصومالية وأفغانية ومصرية وباكستانية وعراقية وكويتية على «إعفائهم من إقامة الحد الشرعي عليهم وصرف معاشات شهرية لعائلاتهم وذويهم الذين سيمنعون من السفر خارج المملكة مقابل تأهيل المتهمين وتدريبهم من اجل إرسالهم الى الجهاد في سوريا».
ـ أن تكون السلطات الأمنية السعودية فقدت القدرة على تعقّب المطلوبين أمنياً، فاستغلوها للهرب من الديار أو سهّلت لهم سفرهم بهدف الخلاص منهم وتنفيذ مآربها في الخارج، خصوصاً مع وجود خصوم مشتركين سواء في سوريا أو العراق أو لبنان.
وكما يلحظ فإن الاحتمالات جميعاً تنطوي على إدانة للسلطات السعودية، لأن أي احتمال يرجح هو في حد ذاته يمس بسيادة الدولة ووظائفها. هذا المشهد كما نراه من الداخل.
على الجانب اللبناني، حيث مسرح الجريمة، فإن المواطن العادي يتساءل عن سر تفوّق العنصر السعودي في الأعمال الارهابية وعلى وجه الخصوص تلك التي تتطلب دوراً انتحارياً. وهنا يتداخل ما هو سياسي وأمني بما هو ديني وتربوي واجتماعي، لأن أية إجابة من نوع «الارهاب لا دين له ولا طائفة» وأن «المملكة في مقدمة ضحايا الإرهاب» تعني استقالة غير مباشرة أمام الواقع المتفجّر، وإغلاق الملف من دون تحميل مسؤوليات. بكلمات أخرى، إبقاء المسرح مفتوحاً أمام فصول دموية متعاقبة.
في السياسة، اختارت السعودية ومنذ ثبوت تورّط مواطنيها في أنشطة إرهابية خارج الحدود من القارة الهندية ومروراً باليمن وصعوداً الى العراق وسوريا ولبنان وصولاً الى روسيا، أن يكون الصمت واللامبالاة وعدم الاكتراث مواقف حتى إشعار آخر، أي حتى تصل الضغوطات مستوى يفرض عليها الخروج عن صمتها وتبني موقف، وإن مريباً، كما حصل في 3 شباط الماضي حين صدر الأمر الملكي بتجريم المقاتلين السعوديين المدنيين والعسكريين في الخارج. ولذلك، وفي السياسة أيضاً، كل الاحتجاجات وأشكال الشجب والتنديد قابلة للاستيعاب ما لم تصدر عن قوى كبرى نافذة مثل الولايات المتحدة ومجموعة دول أساسية في الاتحاد الاوروبي (بريطانيا وفرنسا والمانيا).
حتى الآن، لا يبدو أن السعودية تتعامل بجديّة مع ملف مواطنيها الارهابيين في الخارج. وتكشف تصريحات بعض مسؤوليها عن مستوى الخفّة في التعاطي مع هذا الملف. تصريح السفير السعودي في بيروت علي عسيري بعد يوم من تفجير فندق «دي روي» ينمّ عن تهاون وتوهين، كزعمه أن المستهدف من العملية هو السفارة، لمجرد مجاورة الفندق لها، في محاولة لتصوير السعودية ضحية، والحال أن أجهزة الأمن اللبنانية كشفت في وقت مبكر طبيعة الاهداف المرسومة لعملية الخلية.
هنا يعاد طرح سؤال «الأخبار» مجدداً: كيف نجحت صحيفة «عكاظ» في إطلاق انذار مبكر حيال الوضع الأمني في لبنان كما في افتتاحيتها التحذيرية في 17 حزيران الجاري بعنوان «غداً آخر الفرص»، فيما أخفقت دولة لديها إمكانات استخبارية بشرية وتقنية مثل السعودية في تحذير السلطات اللبنانية من وصول ارهابيين آتين من المملكة، بدلاً من أن تقوم الاستخبارات الألمانية بتزويد الأجهزة الأمنية اللبنانية المعنيّة بمعلومات عن أنشطة إرهابية وشيكة؟!
في التحريض الديني على الارهاب، لا تزال مساجد المملكة تخضع لسيطرة مشايخ التحريض على الجهاد في الخارج، تارة بعنوان مذهبي «الرافضة» و»النصيرية» وأخرى بعنوان قومي «صفوي» وثالثة بعنوان ديني «نصراني، يهودي»، الى جانب مئات بل آلاف مراكز التبليغ الدعوي والمواقع الالكترونية والمعاهد الدينية والمكتبات، فتنشأ عشرات آلاف الدعاة المدججّين بعقيدة تكفير الآخر، فيما تُضَخّ في الأسواق أطنانٌ من النشريات والكتب المحرّضة على مقاتلة أعداء أهل التوحيد!
ورغم ثبوت دور ماكينة التحريض الديني في المملكة السعودية وانخراطها المباشر في أنشطة إرهابية بخلفية مذهبية، إلا أن الحكومة السعودية لم تتّخذ حتى اللحظة تدابير لوقف محرّكات التحريض، أو سن تشريع لتجريم الحض على الكراهية أو العنف. على الضد من ذلك، توسّع مجال عمل التحريض وتمجيد العنف حتى شمل الصحف المحلية كما ظهر أخيراً في توصيف مقاتلي داعش في العراق بالثوّار، والأعمال الإرهابية في الموصل ومحافظات أخرى بـ «الثورة الشعبية».
وأمكن الزعم اليوم أن المؤسسات المولجة بتغذية الرأي العام «دينية وإعلامية وثقافية» تسهم بصورة فاعلة في تعميم خطاب الكراهية والعنف. من المفارقات المذهلة، أن هذه المؤسسات التي صمتت عن ثورات تونس ومصر واليمن والبحرين، وجدت في العراق وسوريا وربما لبنان «ميادين تحرير» لثورات بمقاييس سعودية وهابية. وفي جميع هذه الثورات يحضر عنوان «أهل السنة» كي تتأكد النزعة المذهبية ـ الطائفية وراء عملية التحريض في الاعلام السعودي.
سعوديون في القاعدةعلاوة على البعدين السياسي والديني، فإن عزوف السلطات السعودية عن التعاون الأمني مع السلطات اللبنانية في ملف مواطنين سعوديين مشتبه بهم، ثبت ضلوعهم في تفجيرات داخل لبنان وأخطرهم ماجد الماجد، زعيم «كتائب عبد الله عزّام»، الذي مات في ظروف غامضة في بيروت، وتدخلت الحكومة السعودية على وجه السرعة لاستعادة جثته من السلطات القضائية اللبنانية، يشي بموقف ما بالتأكيد سلبي. في أحسن الفرضيات، فإن السعودية تتوسل التجاهل في التعاطي مع الملف الأمني المتفجّر في لبنان، وقد يوضع في سياق الموقف من حزب الله ومشاركته في القتال في سوريا. ولكن ماذا لو ثبت أن التراخي السعودي ينطوي على أمر آخر، قد يبدأ بغض الطرف عن تحرّك مواطنين سعوديين (سفراً وتمويلاً وتخطيطاً وإعداداً وتنفيذاً)، ويمر بتسهيل مهماتهم الارهابية، وينتهي بالضلوع المباشر في الارهاب الذي يضرب لبنان، تماماً كما ثبت من نتائج التحقيق في تفجير السفارة الايرانية في بئر حسن.
مهما كانت تبريرات السلطات السعودية، فإن الحادثة حين تتكرر بنفس الطريقة وبنفس الأشخاص تكون العفوية آخر الاحتمالات ان لم تكن خارج الممكنات الذهنية والعملانية، إذ ليس في علم الجريمة حادث عابر.
يحضر السعودي بكثافة في الاعمال الارهابية والانتحارية منها على وجه الخصوص، وليس ذلك محض صدفة، أو جريمة لمرة واحدة، وهذا يجعل السعودية في أحسن الفرضيات وأسوأها مسؤولة بصورة مباشرة عن جرائم مواطنيها الذين حسموا أمر فنائهم لأن ثمة من حرّض في الجامع والمدرسة، وسهّل بالمال والأمن، وحضن وشيّع في المجتمع، فالذين يعبرون بالموت الى العالم مرّوا بمرحلة تأهيل في المملكة الوهابية قبل لحظة الانغماس في جسد الآخر.
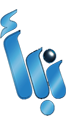 قناة نبأ الفضائية نبأ
قناة نبأ الفضائية نبأ



