* فؤاد إبراهيم
يقول مونتسكيو: “إذا كانت الحرية ثمناً لمن يشتريها، فإنها بلا ثمن لمن يبيعها”.
من خارج الصيرورة الثقافية المحلية والعالمية، تصدّرت “المشهد الشيعي” في المملكة السعودية مجموعة كتّاب من الطائفة من انتماءات متعدّدة: ليبرالية (قضى بعض أفرادها ردحاً في التديّن)، ويسارية، جمع بينها هدف مشترك: نقد الاجتماع الديني الشيعي وتمجيد مملكة آل سعود و”رؤية 2030″، وهي الثيمة الحاضرة بكثافة في كتابات المجموعة.
ابتداءً، لا بد من إلفات الانتباه إلى أن هذه المجموعة لا يصدق عليها مسمّى ظاهرة ثقافية، ولم تكتسب صفة تيار ثقافي، ولكنّ المساحة الممنوحة لها في الإعلام الرسمي يسبغ عليها حالة ثقافية برافعة سلطوية. اختار هؤلاء تمثّل الطاغية في قمع حرية الشريك المذهبي، ولكن من موقع الآخر.
ثمّة خيارات مخاتلة يلجأ إليها أفراد هذه المجموعة تفضي إلى الوقوع في قبضة العبودية الجديدة، السياسية منها بدرجة رئيسة، ومن بينها مخادعة الذات بمشاغلتها بقضايا لا تتطلب ثمناً، من أي نوع، كممارسة النقد الاجتماعي، أو حتى النقد الفكري المقطوع الصلة بالحرية السياسية (أي نقد السلطة الحاكمة). فأولئك الذين يختارون سبيلاً غير سبيل مقارعة الاستبداد السياسي، يقترفون خطيئة بحق شعبهم، حين يسهّلون تبرير الوقوع في حبائل العبودية الطوعيّة، بلغة دولا بويسي. ليس في ذلك، كما يتوهّم بعضهم، دعوة لتعطيل حركة النقد بأشكاله الأخرى، ولكن الشجاعة تقتضي فتح أفق النقد واسعاً وشاملاً وليس انتقائياً، أي أن يختار الناقد ما يجلب السلامة الجسدية والزهو المعنوي، والنأي عن كل ما يجلب الضَّرر الفعلي والمتخيّل، الذي غالباً ما ينجم عن نقد السلطة السياسية.
ومن الضروري تثبيت نقط فصل في أي مناقشة مع هذا الفريق أو غيره، وبالنسبة إلى أولئك الذين اعتمدوا النقد نهجاً في حياتهم ونضالهم، بأن لا خشية لديهم من النقد، ولديهم الشجاعة الكافية لأن يمارسوه ضد ذواتهم. وفي المبدأ، لا غنى للمجتمعات والدول عن النقد لأنه شرط رقيّ، فلا تتقدّم الأمم إلا بنقد ذاتها، واعتماده نهجاً ثابتاً ودائماً. وفي الوقت نفسه، إن الانتقائية في النقد هي خداع للذات، كأن نختار ما يسهل نقده ويرجى ثمنه (مادياً كان أو معنوياً)، والنأي عمّا يتطلّب جسارة المواجهة وتحمّل التبعات. وهذا ما يفعله بعض الكتّاب الشيعة في مملكة آل سعود حيث الشجاعة تتظهّر في أقصى أشكالها، حين يتعلق الأمر بنقد الاجتماع الديني الشيعي، ولكنّها تنقلب جبناً وخوراً حين تقترب من نقد السلطة السياسية، وانتهاكها لحقوق الإنسان ومعتقلاتها المكتظّة بسجناء الرأي، وساحات إعدامها التي تجزّ فيها رؤوس دعاة الحرية والكرامة بسيف الوحشية والظلامية، فحينئذ تجفّ الأقلام وترفع الصحف.
يعتصم أفراد المجموعة بلغة نقدية موغلة في التحريض والشيطنة، لكل ما هو شيعي (دينياً كان أو سياسياً)، ولا غرابة في ذلك، فهؤلاء يتحصّنون بالسلطة، وبجبروتها الأمني، وإمبراطوريتها الإعلامية، في مقابل مجتمع يراد منه الصمت طوعاً أو كرهاً.
طور في العدمية لدى بعض من هذا الفريق، يأخذ شكل إقصاء تام واقتلاعي لكل الآخر، تماماً كما كانت الوهابية الرسمية، ولكن هذه المرة من موقع حامي حمى الحريات والفردانية. يكاد السيناريو نفسه في لعبة الحقيقة والزيف يتكرر، فالتوظيف الانتهازي للقيم ليس حكراً على فئة، ويقدّم هذا الفريق مثالاً بائساً على شعار الطغاة “لا حرية لأعداء الحرية”.
منهجية النقد لدى هؤلاء الكتّاب ليست مؤسّسة علمية، وإن تستّرت بقشرة علمية، ولا يبدو أنهم معنيون بتوليد وعي أو حتى معرفة إجمالية عن حالة ثقافية قائمة بقدر النزوع نحو شيطنة الشريك المذهبي، من موقع الآخر.
ليست الانتقائية، فحسب، هي عنصر التوجيه في الكتابة النقدية لدى هذا الفريق، فما هو أسوأ منه هو التحريض على العقوبة. بمثل هذه اللغة يمكن توقّع ردود الأفعال، كأن تقدم الأجهزة الأمنية على اعتقال رجل دين بعد مداهمة منزله بطريقة مافيوية وتفتيشه وإخضاعه لتحقيق شامل، عقب نشر مقالات عنه في صحيفة “النهار” اللبنانية. وللإشارة، فإن اختيار هذه الصحيفة لنشر مقالات ذات خصوصية شديدة، محلية واجتماعية، مقطوعة الصلة بالسياق الثقافي اللبناني ليس عبثياً وإن بدا طفولياً. فهو في الظاهر، يتموضع في معادلة التجاذب السياسي الداخلي في لبنان، وفي تفصيحه السياسي والإعلامي يتطلّع نحو موازنة ما تنشره صحيفة “الأخبار” من مقالات لكتّاب معارضين للنظام السعودي والبحريني.
خدر الضمير لدى بعض الأقلام الشيعية في مملكة آل سعود يصل إلى حد التعامل مع خبر إعدام شباب دونما محاكمة عادلة، أو اعتقال أشخاص بطريقة تعسفيّة بطريقة التشفّي، بحمله على ذريعة ممارسة حرية التعبير التي تكون امتيازاً حصرياً لطرف دون آخر.
لا تعكس الرطانة الثقافية والتلطي وراء كومة مصطلحات مقطوعة السياق السياسي محلياً ما خلا التوظيف الهابط في معركة غير متكافئة، بغرض نفي الآخر واقتلاعه، وليس تعبيراً عن التزام من أيّ نوع بموجبات المفاهيم التي يجري استخدامها لمحاكمة الآخر. حرية الرأي والمعتقد، والانفتاح، والحوار، والاعتدال، والفردانية في سياقها الليبرالي، مفاهيم إنسانية وثقافية يجري توظيفها في المناكفة العبثية لغرض الانتقام الشخصي من الآخر، الديني، لا بغرض الصعود بمنسوب الوعي المجتمعي، ولا تحرير الفرد من هيمنة السلطة، أي سلطة، لما ينطوي عليه من تداعيات سياسية. ولا غرو، والحال هذه، أن تلك المفاهيم لا نصيب لها في التداول الثقافي المحلي، فضلاً عن السياسي، وقد مثّل عهد سلمان وصبيته النموذج الأسوأ في التاريخ الأسود لمملكة آل سعود، على مستوى العلاقة بين المجتمع والسلطة. غياب شخصية محمد بن سلمان (صاحب السجل الأكثر دموية وسادية في الوقت الراهن) في دوّامة الاحتجاجات الثقافية لدى كتّاب الشيعة في مملكة آل سعود ليس من قبيل السهو المغفور، حيث القطيعة بين الحرية والانفتاح والتسامح والرأي الآخر وبين سلطة جبلت على إفناء الآخر وتقطيع أوصاله. فغياب ابن سلمان، كما حضوره، يتم بطريقة انتقائية أيضاً، بحسب الموضوع. إن تغييب نظام سلمان وصبيته في جدال الحرية، وحرية التعبير أولاً، وتكثيف استخدامها في هيئة جرعة تهويلية ضد الشريك، الديني، يشي بنزوع استغلالي لمفاهيم نبيلة في معركة هابطة. ولذلك، تبدو عبثية وعقيمة موضعة ابن سلمان في سردية الإصلاح، اللهمّ إلا أن تكون الوصفة النيوليبرالية (برغم من كارثية تجاربها) في تمظهرها الاجتماعي، معزولة عن السياسي، هي غاية المنى، كما تظهرها نوبات الردح البائسة في كتابات مثقفي السلطة.
اختيار «النهار» لنشر مقالات مقطوعة الصلة بالسياق الثقافي اللبناني ليس عبثياً وإن بدا طفولياً وفي تفصيحه السياسي والإعلامي يتطلّع نحو موازنة ما تنشره «الأخبار»
كتابات هذا الفريق لا تندرج في سياق النقد الثقافي، بل هو نقاش سياسي بلغة ثقافية ومفعول أمني، إذ يضع نقد الخطاب الديني في بعده الاجتماعي في مواجهة مع “رؤية 2030″، ليخرج في هيئة تمرّد على سياسة الدولة وتالياً تبرير العقوبة.
وبلغة حداثوية تروق لهذا الفريق، أن الحرية هي، في الجوهر، تنوّع لانهائي، لأنها تحترم كل الإرادات، وحين تحتكر الحرية من طرف ويقاتل من أجل حرمان الآخرين منها بدعوى أنهم يقفون أمام التقدّم والمسار الذي يسلكه، تنقلب الحرية استبداداً، ولطالما كان لهذا الاتجاه قدم راسخ في الاستبداد والمصادرة، قولبناه في جملة مقتضبة “تنزيه الذات وتوصيم الآخر”، وإن كان التعبير عنها بمفردات مستمدة من قاموس الحرية نفسها.
وحتى لا يقع هذا الفريق تحت وطأة وهم المنجز السلطوي، على فرضية حصوله، فمن الأخلاقي لفت الانتباه إلى نقطة جوهرية مفادها أن الحقوق ليست هبات، وإنما هي خصائص وامتيازات ترافق الإنسان منذ ولادته، ولذلك يصرّ هربرت سبنسر على رفض الفكرة القائلة بأن حقوق المواطن هي ما تقرّرها الحكومة وحدها. كما أن الحقوق ليست استنسابية، ولذلك، يقترح سبنسر قانوناً واضحاً يكفل لجميع الأفراد حقوقاً متساوية، وأن تكون هذه الحقوق هي الحكم الشامل للجميع، أي قانون يقوم على الحريّة المتساوية للأفراد كافة، ويمنع أي فرد من انتهاك هذا القانون، وهذا وحده يؤسّس لمشروعيّة الرابطة بين الفرد والدولة.
ولكن حتى القانون قابل للانتهاك، في ظل اختلال موازين القوى بين المجتمع والدولة، ومعه تختلّ معادلات كثيرة. وقد وصم بيردييف الوعي بـ “الضمير التعيس” الذي قد يسوق صاحبه إلى العبودية، حين يدخل في لعبة القانون التي تملي عليه العمل وفق شروط الآخر، أياً كان هذا الآخر (والسلطة في مقدّمها)، وهي شروط ليست متوافقة مع منسوب وعيه.
ما يُرمى به الآخر (الديني هنا)، بالجمود على خيار ثقافي يخلع عليه مشروعية دينية ونفي الخيارات الأخرى، وتالياً التحريض على اقتلاعه، يمارسه المثقف السلطوي حرفياً مع فارق أن الأخير يتحصّن بقوة مادية، أي الدولة، وأيّ دولة؟! إن الاحتجاج بأن الآخر يحتمي خلف ساتر ديني في تصويبه على المختلف يرتدّ عكسياً على المثقف السلطوي نفسه، ولا سيما في رمي الديني بالتخلّف والرجعية، وبما حواه إرث السجالات الإيديولوجية بين الديني والعلماني في سرديات الحداثة. ويبقى، أن جدالات الشأن العام تبقى محكومة بقوانين حرية الفكر، ما لم تكن السلطة السياسية طرفاً، فحينئذ لا تعود مناقشات فكرية، بل سياسية وتالياً أمنية.
إنّ أوّل ما تلجأ إليه السلطة للحدّ من الحريات هو القوانين الجزائية، حيث تقوم السلطة، وبيسر بالغ، باستخدام تلك القوانين وتوجيه اتهام بإساءة الحريّة تحت طائلة التعدّي على الحق العام أو الخاص، ولذلك لفت مونتسكيو إلى أنّ حريّة المواطن تتوقف على صلاح القوانين الجزائية خاصة.
في حقيقة الأمر، إنّ القانون الذي يتطلّع إليه المواطنون ليس ما ينطوي على تقييد لحرياتهم، بل ما يمنع تغوّل السلطة، وهو ما لفت إليه هايك بتحرير حكم القانون من الامتيازات والاستثناءات لأشخاص معيّنين تحدّدهم السلطة، وهذا وحده الكفيل بحماية مبدأ المساواة أمام القانون والمانع لتشكّل الحكم الاستبدادي.
المثقف السلطوي بعجرفة مستعارة، يمارس إقصاءً متعالياً ضد شريكه المذهبي بالمعنى الإثنولوجي وليس الديني، عن طريق تنصيب نفسه في موقع المناصر للعلم والحداثة والانفتاح والحرية ونفيها عن الآخر. ما يؤسف له، أنه يفعل ذلك من موقع التماهي مع السلطة، وليس حرية التعبير التي يجد مرتعها القاحل في الفضاء الإعلامي للسلطة.
إنّ أسوأ ما قد يواجه مجتمعاً ما أن يتقمّص المثقف دور رجل الأمن، لمّا ينزاح عن محيطه الطبيعي، وينحاز إلى البلاط، ولك، حينئذ، تخيّل نوع الخطاب الذي ينسجه والأجندة التي يحملها. نفثة مصدور أطلقتها مدام رونالاد، أحد رموز الثورة الفرنسية، وقد أعدمت سنة 1793 بسبب آرائها، واختصرت أزمة الحرية بعبارة: “الأمن هو مقبرة الحرية”.
إن الجملة البائسة التي تردّد في بعض أصقاع العالم، والعربية منها على وجه الخصوص: “الحمد لله على نعمة الأمن والأمان”، وهي ليست سوى دعوة مفتوحة للسلطة بأن تغرز مخالبها في أجساد رعاياها، وهي، في الوقت نفسه، عملية استدراج للطغاة لسنّ ما يشاؤون من تشريعات وابتكار إجراءات تنتهي، في خاتمة المطاف، إلى استعباد الرعيّة. تذكير الدولة بمهمتها الأساس، أي حفظ الأمن، لا يتطلّب الاستجداء الخادع والمهين، لأن النتيجة، أو بالأحرى الثمن، هي خسارة الحريّة والوقوع في حبائل الاستعباد. وبحسب توكفيل فـ«الأمّة التي لا تطالب حكومتها إلّا بالسهر على الأمن والنظام، أمة مستعبدة”.
باسم الحفاظ على الأمن، يتمّ انتهاك الحريّات عموماً، وليس أهون على الأنظمة الشموليّة من أن تخوّف الناس من وقوع أخطار ما قادمة حتى تحصل على أكبر تأييد شعبي بفرض إجراءات أمنيّة صارمة.
إنّ اللعب بورقة الأمن هو امتياز حصري لدى السلطة السياسية، فمنها تكتسب مشروعيّتها الشعبيّة، ومنها تعزّز أركانها، ومنها تبيح استعمال ما تشاء من أدوات القمع باسم “حفظ الأمن”. ولطالما أسرف كتّاب شيعة في مملكة آل سعود في الرقص على جثث شهداء العوامية والقطيف عموماً، مستأنسين إلى رواية الخصم، أي وزارة الداخلية وأفرعها القديمة والمستحدثة، وآخرها جهاز أمن الدولة، واحتساب روايتها نهائية وغير قابلة للطعن، أو حتى التحفّظ. فالأمن هو أمن السلطة وليس المجتمع، وعليه، فإن حفظ الأمن كفيل بتبرير كل إجراء يوصل إليه (أي إلى أمن السلطة).
إنّ ما سبق يعيد التذكير بالتكتيك القديم، فمن أجل أن ينزع المستبد الشرعية عن خصومه يحمّلهم مسؤولية تهديد الأمن، وظاهره أمن الناس وباطنه وحقيقته أمن السلطة. وبذريعة ماكرة كهذه، يحتكر المستبد سلطة فرض النظام واستعادة الأمن، وفي الوقت نفسه يجرّد الخصوم من أي غطاء شعبي، أي شيطنة المعارضين له.
ليس من وسيلة لمصادرة الحريّة أسهل من رفع درجة التهديد الأمني في البلاد، والذي يتمّ، في بعض البلدان، تحت قانون “إعلان حال الطوارئ” وفي أحيان كثيرة يجري ذلك من دون إعلان، وهو ببساطة بمنزلة بلاغ استباقي عن وجود تهديد أمني بمستوى مرتفع للغاية يحدق بالبلاد، وهو الشرط التمهيدي لتبرير الإجراءات الأمنيّة الاستثنائية في عموم المناطق، حيث يتم تعطيل العمل بالدستور.
لهؤلاء الكتّاب، الذين اختاروا الاصطفاف إلى جانب الطاغية، ونذروا أقلامهم لخدمته وساهموا في تأخير لحظة التغيير الحقيقي، القائم على الشراكة الشعبية الكاملة في بناء مجتمع الحرية والعدالة والمساواة بدعوى أن سلمان وصبيته من دعاة الليبرالية والانفتاح والاعتدال، نذكّر بما جرى في لقاء جرى بعد تولّي فهد العرش في عام 1982؛ جمع عدداً من قيادات الحزب الشيوعي في الجزيرة العربية مع وليّ العهد الأمير عبد الله، الملك لاحقاً، العائدين من المنفى، فتحدّث معهم بلغة اليسار، وأخبرهم بأن الصحافة الأميركية تصفه بالأمير الأحمر، لانحيازه إلى جانب قضايا العمّال والطبقات الفقيرة ومناهضة الرأسمالية الأميركية. خرج هذا النفر وهم يفركون أيديهم لفرط ما سمعوا من ترّهات، فهل وصلت الرسالة؟
* فؤاد إبراهيم باحث من الجزيرة العربية وقيادي في “لقاء” المعارضة في الجزيرة العربية”
المصدر: صحيفة “الأخبار” اللبنانية
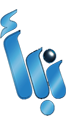 قناة نبأ الفضائية نبأ
قناة نبأ الفضائية نبأ



